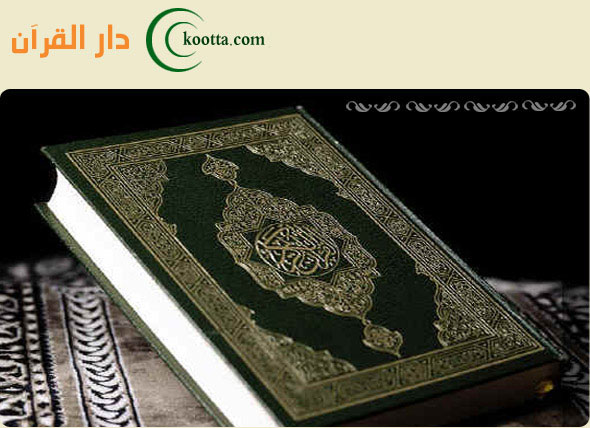لا ينسب النجاح إلى أي تشريع فيما
وضع لأجله إلا إذا تحققت فيه أربعة عناصر، أولها أن يؤدي الغرض الذي وضع من أجله،
وثانيها أن يتم له ذلك في أقل زمن، وثالثها أن يكون ذلك الغرض قد تحقق بأقل ما
يمكن من التكاليف، وآخرها ألا تكون سلبياته أكثر من إيجابياته، فإذا انعدم عنصر
واحد من هذه العناصر لم يكن التشريع ناجحا ولا فعالا في ما وضع من أجله، وفي موضوع
مكافحة الجريمة فإن النجاح مرهون بالتقليل من نسب الجريمة في زمن قياسي مع اجتناب
التكاليف الباهظة والإفرازات السلبية التي تخلفها عملية المكافحة.
ومن خلال دراساتي المتعددة لأنظمة التجريم والعقاب من
العصور البدائية إلى اليوم(1) لم أجد هذه العناصر الأربعة قد تحققت كلها ولا حتى نصفها إلا في تشريع
واحد هو التشريع الذي جاء به القرآن الكريم في ميدان مكافحة الجريمة، والموجود في
نصوص القرآن، والمبين في السنة الشريفة، والمفسر في أقوال الصحابة الكرام
وتطبيقاتهم وأقوال العلماء من بعدهم . ورب سائل عن حقيقة توفر هذه العناصر في
التشريع القرآني ومدى تفرده في ذلك، وسوف أقدم بيانا بذلك من ما يلي :
أولا : نجاح التشريع
القرآني في مكافحة الجريمة في زمن يسير:
إن أصدق ما يدل على
نجاح هذا التشريع في مكافحة الجريمة هو ما تسفر عنه المقارنة بين حال الجريمة في
المجتمع العربي قبل الإسلام وما أصبحت عليه بعده بزمن يسير، فعندما نزل القرآن
الكريم على العرب كانت الجريمة فيهم هي الأصل، فكانت الأوثان تعبد، والأرحام تقطع،
والأموال تنهب، والأرواح تزهق، والغزوات على قدم وساق، ولعل أوجز ما يعبر عن حالهم
هو قول شاعرهم وحكيمهم زهير ابن أبي سلمى :
ومن لا يذد عن حوضه
بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس
يظلم
ولم يلبث نزول الوحي فيهم إلا ثلاثا
وعشرين عاما حتى تغير حالهم من النقيض إلى النقيض، وأصبحت الجرائم فيهم استثناء
بعد أن ظلت أصلا لمئات السنين، فتحولت العداوة إلى أخوة فاقت أخوة النسب، وتحول
الانتقام إلى تسامح، وانتشر الأمن في ربوعهم حتى سار الواحد منهم من شرق الجزيرة
إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، وتحقق فيهم
قول القرآن الكريم : (واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين
قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً)(2)، في حين أن القوانين
الوضعية الحديثة التي يعتبرها أهلها أكثر القوانين إحكاما في مجال مكافحة الجريمة
لم تنجح بعد فيما وضعت من! أجله وهو مكافحة الجريمة بعد مرور أكثر من قرنين على
تاريخ وضعها، وهذا باعتراف أهلها الأصليين ومنهم قاض في محكمة النقض الفرنسية الذي
تعتبر بلاده قبلة العالم اليوم في مجال التشريع خصوصا مستعمراتها السابقة ومنها
الجزائر . قال السيد موريس باتان
رئيس محكمة النقض الجزائية الفرنسية في افتتاح مؤتمر الوقاية من الإجرام المنعقد
في باريس سنة 1959 : أنا لست إلا قاض في جهاز العدالة لم يخطر على بالي في أي وقت
من الأوقات الاهتمام بأسس الوقاية من الإجرام لأن وظيفتي لم تكن هناك بل على العكس
فقد كانت ولا تزال في العقاب لا في الحماية، كرست حياتي تبعا لمهنتي القضائية الطويلة
في محاربة المنحرفين حربا سجالا لا هوادة فيها، سلاحي الوحيد الذي وضعه القانون
تحت تصرفي سلاح العقاب التقليدي، أوزع الأحكام القاسية والشديدة أحيانا على جيوش
المجرمين والمتمردين ضد المجتمع ،ساعيا ما أمكن إلى التوفيق بين نوعية العقاب وما!
هية الجريمة ،وكنت أسأل نفسي دوما كما كان الكثيرون من زملائي يتساءلون أ يضا عما
إذا كان هذا السلاح قد أصبح في يدنا غير ذي شأن، وقد شعرت ولا أزال أشعر بكثير من
الألم والمرارة بما كان يشعر به أولئك الذين تحدثنا الأساطير عنهم، أنهم كانوا
يحاربون المسخ فكانوا كلما قطعوا رأسا من رؤوس هذا المسخ تنبت محله رؤوس ورؤوس،
وقد تعاقبت السنوات وأنا ألاحظ بدهشة أن عدد المجرمين لا يزال مستقرا إن لم يصبح
متزايدا، وأنه كلما كنا نرسل الكبار منهم إلى السجن أو إلى المنفى أو إلى المقصلة
كان غيرهم يخلفهم في نفس الطريق بأعداد أكثر منهم(3).
فهذا كما هو واضح اعتراف صريح
بفشل القوانين الحديثة في مكافحة الجريمة وشواهد الحال والإحصائيات تؤكد هذا
الكلام، وإنما نقلته في هذا المقام من باب (وشهد
شاهد من أهلها )(4) .
إن نجاح التشريع
القرآني غير مرتبط بالصرفة كما يمكن أن يدعيه البعض، كأن يقولوا مثلا إنما صرف
الله القلوب والنوازع عن أن تفكر في الجريمة أو تقدم عليها على نحو صرفه للعرب أن
يأتوا بمثل القرآن، وهو كلام غير صحيح أيضا فقد حاول بعض المتنبئين أن يأتوا بمثل
القرآن ولكنهم فشلوا في ذلك مثل مسيلمة الكذاب، وإنما نجح التشريع القرآني فيما
فشلت فيه القوانين الوضعية الحديثة بحكم اعتماده على منهج علمي فريد في مكافحة
الجريمة، وكل مجتمع استند إلى هذا المنهج لا يشك أبدا في نجاحه مهما كان زمانه
ومكانه، وهذا المنهج استقرأناه من النصوص المختلفة الواردة سواء في القرآن أو
السنة، وهذا المنهج هو الذي نجح به التشريع القرآني في تلك الفترة الزمنية اليسيرة
.
منهج الإسلام في مكافحة
الجريمة
الجريمة سلوك شاذ، يهدد أمن
الأفراد، واستقرار المجتمعات، ويقوض أركان الدول، ولذلك اهتمت المجتمعات قديما
وحديثا بموضوع التصدي للجريمة ومكافحتها، ولم يخل مجتمع من آلية ما لمكافحة
الجريمة، وقد تطورت هذه الآليات مع تطور المجتمعات، فبعد أن كانت مقصورة على
العقاب وحده، وصلت في الدول والمجتمعات الحديثة إلى ثلاث، هي الوقايةوالإصلاح
–العلاج – والعقاب، وتكشف الإحصائيات الحديثة أن هذه الوسائل لم تحقق ما هو مطلوب
منها، ولذلك انبرى الباحثون في علمي الإجرام والعقاب للبحث عن وسائل بديلة، ولا
يزال البحث ساريا. كما التأمت الجهود الدولية حول مؤتمرات علم الإجرام التي تنظمها
هيئة الأمم المتحدة بصورة دورية ابتداء من عام 1951 ووصل عدد تلك المؤتمرات إلى
عشر، عقد آخرها في فيينا سنة 2000، هذا فضلا عن المؤتمرات التي كانت تعقد تحت ما
يسمى بالقومسيون، وقد توسع المشاركون كثيرا في تشخيص الأسباب، كما اختلفت نظرياتهم
في سبل الكفاح والعلاج، وأنفقت بشأن ذلك أم! وال طائلة ولم يتغير شيء في أرصدة
الدول المشاركة من نسب الجريمة، بل إن الجريمة في زيادة مطردة، وفي كل يوم يتخرج
إلى المجتمع أو منه دفعات من المجرمين في مختلف صنوف الإجرام وأنواعه مما يدل على
أن المناهج المتبعة في مكافحة الجريمة منيت بفشل ذريع الأمر الذي يدعو إلى البحث
عن مناهج بديلة إذا كانت هناك نية صادقة لمكافحة الجريمة .
والإسلام
باعتباره دين صلاح وإصلاح قد تصدى للظاهرة الإجرامية حتى أصبح وقوع جريمة استثناء
من الأصل العام في الاستقامة، وكثيرا ما كان المجرم يسعى بنفسه إلى إقامة الحد
عليه أملا في تطهير نفسه من الذنب الذي ارتكبه، وقد حدث ذلك كله في مجتمع كانت
الجريمة فيه هي الأصل، خصوصا جرائم القتل والسرقة والنهب والزنى، إلى جانب بقية
الجرائم الأخرى وإلى بعض ذلك يشير قوله تعالى : (
واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا )(5)، كما عبر عن ذلك جعفر ابن أبي طالب في خطبته أمام النجاشي عندما قال : (كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام و نأكل الميتة و نأتي الفواحش و نقطع
الأرحام و نسيء الجوار و يأكل القوي منا الضعيف )(6).
إن الانقلاب الذي أحدثه
الإسلام في المجتمع العربي، وتحويل الظاهرة الإجرامية من أصل إلى استثناء فيه دليل
قاطع على أن آلياته في مكافحة الجريمة كانت ناجحة جدا، وما دام أن المجتمعات
الإسلامية الحديثة لم يصل فيها مستوى الجريمة لأن يكون أصلا كما كان عند العرب قبل
الإسلام فإن منهج الإسلام هو الأقدر على مكافحتها بفعالية وبثمن أقل، ولذلك فإن
الكشف عن هذا المنهج أصبح من قبيل الواجب الذي ينبغي أن يوضع موضع التنفيذ،
خصوصا مع استفحال الظاهرة الإجرامية وعجز المناهج والأساليب التي وضعت لمكافحتها.
وباستقراء نصوص الوحي
المتعلقة بالموضوع والواردة في القرآن والسنة، وبالتأمل في أحداث السيرة النبوية
وما صاحبها من أخبار، وما حكم به الخلفاء الراشدون، وما قاله بعض الصحابة – رضوان
الله عليهم أجمعين – وجدت أن منهج الإسلام في مكافحة الجريمة بقوم على أسلوبين
رئيسيين، الأول هدفه منع وقوع الجريمة أصلا، أما الثاني فهو يأتي بعد وقوعها وهدفه
منع تكرارها سواء من فاعلها أو من غيره.
ويسمي علماء الإجرام المحدثون
الأسلوب الأول وقاية، والثاني يسمونه علاجا أو عقاباً .
أولا :
الأسلوب الوقائي :
يشكل هذا الأسلوب سبقا
تشريعيا انفرد به الإسلام على مدى يصل إلى أكثر من عشرة قرون، ولم يلتفت المشرعون
الغربيون إلى هذا الأسلوب إلا في القرنين الأخيرين بعد دراسات وبحوث طويلة يعود
فيها الفضل إلى علماء الإجرام ومع ذلك فإن ما اقترحوه لا يزال عديم الفعالية بدليل
ما يسجل من زيادات مطردة في نسب الإجرام، ثم إن هذا الأسلوب عندهم يشغل حيزا صغيرا
جدا إلى جانب الحيز الأكبر الذي يشغله العلاج والعقاب . أما الإسلام فلا تقل مساحة
حيز هذا الأسلوب عن مثيلتها في العلاج إن لم تزد عليها بقليل، ويمتد هذا الأسلوب
بشكل متدرج من نفس الجاني المفترض إلى أن يصل إلى المجتمع كله وفق تسلسل منطقي لا
يليق تقديم مرحلة أو تأخيرها عن مكانها، وهذا امتثالا لسنة الله في التغيير
والإصلاح التي تلخصها هذه الآية : ( إن الله لا يغير ما
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )(7) . ويقوم هذا
المنهج على المراحل التالية:
1-الإصلاح الذاتي : فأول ما جاء به الإسلام هو تغيير النفوس من الداخل عن طريق الإقناع بالحجة
والبرهان، فالقلب هو الذي بيده أمر الجوارح التي تقترف بها المعاصي وترتكب بها
الجرائم، فإذا أمسك بزمام القلب فقد تم الإمساك أيضا بزمام الجوارح، لكن كيف تم
للإسلام الإمساك بزمام القلوب ؟ . لقد تم للإسلام ذلك عن طريق ربطه بالإيمان بالله
تعالى لأن الإيمان عملية ضرورية و قوة خلاقة تحمل الناس على العمل و
الالتزام، و لم ينكر أحد هذا الدور للإيمان حتى الملحدون أنفسهم و في هذا المعنى
يقول الشيخ يوسف القرضاوي :ولقد رأينا من المفكرين و الفلاسفة من لا يؤمنون بالله
ولكنهم يؤمنون بالإيمان بالله - أي يعتقدون بنفع هذا الإيمان - باعتباره! قوة
هادية موجهة، و قوة مؤثرة دافعة، وقوة منشئة خلاقة، لم
يستطع هؤلاء أن يجحدوا ما للإيمان
بالله من طيب الأثر فـي نفس الفرد و في حياة المجتمع، فقال بعضهم : لو
لم يكن الله موجودا لوجب علينا أن نخلقـه (8)، ولعل هذا أيضا ما يفسر اتخاذ المجتمعات
القديمة لآلهة من صنع أيديهم لما يعلمونه من فائدة بالنسبة للاستقرار الاجتماعي، و
يقوم الإيمان في الإسلام على ستة أركان و لكل دوره في التأثير على الفرد، فعندما
يؤمن الفرد بالله و ما له من صفات كالسمع والبصر يشعر و يعلم أنه مراقب في كل مكان
وفي كل زمان وتتولد عنده رقابة ذاتية و هي أهم بكثير من رقابة الغير الذين يجوز
عليهم الغفلة ! و النسيان و غير ذلك من النقائص، وعندما يؤمن بالملائكة وخصائصهم و
طبيعة وظائفهم يعلم أن كل ما يقوله أو يفعله يسجلونه عليه فيدفعه ذلك إلى اجتناب
ما قد يسجل عليه و منها الجرائم، و عندما يؤمن باليوم الآخر و ما فيه من حساب و
عقاب يدفعه ذلك إلى اجتناب ما قد يحاسب عنه يومئذ، روي أن عمر بن الخطاب – رضي
الله عنه – سمع يوما امرأة غاب عنها زوجها في الجهاد تقول : تطاول هذا الليل
واخضر جانبه وأرقني إذ لا خليل ألاعــبه
فوا الله لولا
الله لا شيء غـيره لحرك من هذا السرير جوانبه
وفي رواية أخرى ذكرت أبيات غير هذه
آخرها هذا البيت:
ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفتر
الدهر كاتبه
فسأل ابنته حفصة كم تحتاج
المرأة إلى زوجها ؟قالت : في ستة أشهر، فكان لا
يغزو جيشاً له أكثر من ستة أشهر(9). وروى
ابن القيم في الطرق! الحكمية عن علي – رضي الله عنه – أنه أتي برجل وجد في خربة
بيده سكين متلطخة بدم، وبين يديه قتيل يتشحط – أي يضطرب – في دمه، فسأله فقال :
أنا قتلته، قال : اذهبوا به فاقتلوه، فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرعا، فقال : يا
قوم، لا تعجلوا ردوه إلى علي، فردوه فقال الرجل : يا أمير المؤمنين، ما هذا صاحبه
أنا قتلته، فقال علي للأول: ما حملك على أن قلت أنا قاتله ولم تقتله ؟ قال : يا
أمير المؤمنين، وما أستطيع أن أصنع وقد وقف العسس على الرجل يتشحط في دمه، وأنا
واقف وفي يدي سكين، وفيها أثر الدم، وقد أخذت في خربة وخفت ألا يقبل مني، وأن يكون
قسامة، فاعترفت بما لم أصنع، واحتسبت نفسي عند الله . فقال علي : بئس ما صنعت فكيف
كان حديثك ؟، قال : إني رجل قصاب، خرجت إلى حانوتي في الغلس، فذبحت بقرة وسلختها،
فبينما أنا أصلحها والسكين في يدي
أخذني البول، فأتيت خربة كانت بقربي فدخلتها، فقضيت حاجتي، وعدت أريد حانوتي، فإذا
أنا بهذا المقتول يتشحط في دمه فراعني أمره، فوقفت أنظر إليه والسكين في يدي، فلم
أشعر إلا بأصحابك قد وقفوا علي فأخذوني، فقال الناس : هذا قتل هذا، ما له قاتل
سواه، فأيقنت أنك لا تترك قولهم لقولي، فاعترفت بما لم أجنه . فقال للمقر الثاني :
فأنت كيف كانت قصتك ؟ فقال : أغواني إبليس فقتلت الرجل طمعا في ماله، ثم
سمعت العسس فخرجت من الخربة، واستقبلت هذا القصاب على الحال التي وصف، فاستترت منه
ببعض الخربة حتى أتى العسس، فأخذوه وأتوك به، فلما أمرت بقتله علمت أني سأبوء بدمه
أيضاً، فاعترفت بالحق . فقال للحسن: ما الحكم في هذا ؟ قال : يا أمير المؤمنين :
إن كان قد قتل نفساً فقد أحيا نفساً، وقد قال الله تعالى:(ومن
أحياها فكأنما أحيا الناس! جميعا )(10)، فخلى علي
عنهما، وأخرجت دية القتيل من بيت المال(11). فهذان المثالان فيهما إشارة واضحة إلى أثر الإيمان، ففي المثال الأول كان
الإيمان باليوم الآخر و ما فيه من العذاب مانعا من جريمة الزنا، ونفس الإيمان هو
الذي كان السبب في إحياء نفسين في المثال الثاني .
و لم يكن الإيمان الذي
دعا إليه الإسلام مجرد أقوال أو أفكار،بل ضبطه و حوله إلى حقيقة واقعية عن
طريق العبادات، وهي أقوال وأفعال تصقل النفوس و تربيها حتى يكون تغيير القلب
مصحوباً بتغير في الجوارح كلها، والمتأمل في أنواع العبادات وحسن ترتيبها وتنويعها
يدرك هذه الحقيقة، فالصلاة مثلا وهي من أوائل وأهم العبادات المفروضة في الإسلام
تتوزع على خمسة أوقات في اليوم وذلك يؤدي إلى المحافظة على تهذيب النفس وصفائها
طوال اليوم، وقد كان لهذا التوزيع أثر كبير في صرف الناس عن شرب الخمر قبل تحريمها
نهائيا و ذلك عند نزول قوله تعالى : (يا أيها الذين
آمنوا لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون )(12)،كما أن الصيام يعتبر مدرسة روحية لها الأثر الكبير في تهذيب النفوس و إماتة
نوازع الشر فيها قبل أن تتحول إلى حقيقة واقعة و لذلك قال الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كماكتب على الذين من قبلكم لعلكم
تتقون )(13).وورد في الحديث الشريف قوله –صلى الله عليه
و سلم – : ( ..و الصيام جنة ..) (15)
إن أكثر الجرائم التي
تقع من المسلمين اليوم تقع في العادة من أناس ضعيفي الإيمان، تاركي الصلاة
والصيام، وهذا ما لاحظته بحق في المحيط الذي أعيش فيه، فما أحوج أولوا الأمر من
المسلمين اليوم أن يهتموا بتقوية الإيمان و حمل الناس على الالتزام
بالعبادات، لأن الجرائم تأتي في الحال الذي ينزل فيه الإيمان إلى أدنى
درجاته، و لذلك ورد في الحديث : (لا يزني الزاني حين يزني
و هو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن)(16)، وبالمقارنة
بين إحصائيات الجرائم في كل من أمريكا وروسيا ومصر والعربية السعودية لاحظت أن
أدنى نسبة سجلت في السعودية تم تليها مصر ثم أمريكا التي تسرق فيها سيارة كل
دقيقتين، وأعلى نسبة سجلت بروسيا، وهي نسب تتماشى مع مدى الالتزام الديني لا مع
كثرة القوانين وكثرة رجال الشرطة وهذا الجانب على أهميته لا وجود له في التشريعات
الوضعية الحديثة.
2 – واجب الأسرة : وفيها يتعين وجوب التربية على الأبوين أساسا وهذا العامل يساعد على
إنشاء العامل السابق، لأن الإيمان والالتزام بالعبادات ومكارم الأخلاق لا ينشأ من
فراغ بل هو يبدأ قبل ولادة الإنسان ويستمر إلى وقت البلوغ، واهتمام الإسلام بهذا
الجانب يبدأ من وقت اختيار الزوجة المنتظر أن تكون أول مدرسة يتعلم فيها الطفل،
ولذلك حرم الإسلام الزواج من غير المؤمنات، ودعا إلى اختيار ذوات الدين منهن، وحث
على الاهتمام بالتربية، ومن ذلك قوله تعالى : (
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة )(17)،وقال الرسول – صلى ا! لله عليه وسلم - :
( من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة (18)،وقد أعطى النبي – عليه الصلاة والسلام – توجيهات تطبيقية لكيفية تربية
الأبناء، فبعد أن أمر بحسن اختيار أمهاتهم، أمر أيضا بحسن اختيار أسمائهم، كما
أعطاهم المنهاج الذي يجب اتباعه في حملهم على تكاليف الدين وأخلاقه فقال : ( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم
أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع) (19)،ونب!
ههم إلى أن الأولاد يتعلمون بالقدوة بما يعني واجبهم في الالتزام أمام أب نائهم،
ولقد أتت هذه التربية أكلها فانخفضت نسبة الإجرام في زمن التابعين – وهم أبناء
الصحابة – انخفاضا كبيرا .
وقد أنشأ المسلمون بعد
ذلك ما يعرف بالحسبة والمحتسب، ووظيفة المحتسب هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم، وكثير من الأمور الدينية هو
مشترك بين ولاة الأمور فمن أدى فيه الواجب وجبت طاعته فيه (30).
3- واجب الأسرة الكبيرة (العاقلـــة ):العاقلة هم أقارب الشخص من جهة أبيه، وقد حملهم الإسلام جزء من تربية
الأولاد، ويتضح ذلك من خلال ما فرضه الإسلام في دية القتل الخطأ ودية القتل شبه
العمد التي يجب أن تشترك في أدائها العاقلة مع القاتل، وهذا خلاف للقاعدة القرآنية
التي تجعل المسؤولية على إطلاقها سواء كانت مدنية أو جزائية مقصورة على القاتل
وذلك بنص قوله تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى
)(20)، ومفيد ذلك أن أقارب الرجل من جهة أبيه
مدعوون لمراقبة أبناء بعضهم بعضا حتى ل! ا يجدون أنفسهم يوما مضطرين للتعويض عما
لم يقترفوه، و هذا يؤدي بهم حتما إلى التعاون في التربية، و هذا من شأنه أن يعوض
عن النقص الذي يشوب عمل بعض الأولياء في تربية أبنائهم، فيعودونهم على التزام
الحيطة و الحذر، فضلا عن الانحراف، وموضوع العاقلة لا يوجد له نظير في التشريعات
الحديثة .
4 - واجب الجيران و الرفاق :
فقد حمل الإسلام جيران الجاني أو
رفاقه جزء من المسؤولية فيما يرتكب من جرائم على أرضهم أو في محالهم و ذلك من خلال
تشريع القسامة التي اعتبرها العلماء أصلا من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام
وركن من أركان مصالح العباد أخذ بها كافة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم
(21)، وأصل القسامة أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في
النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود فلما جاء أهله إلى النبي – صلى الله
عليه وسلم – قال لهم : يقسم خمسون منكم على رجل
منهم فيدفع برمته، قالوا : أمر لم نشهده كيف نحلف ؟ قال : فتبرئكم يهود بأيمان
خمسين منهم ...(22)، و لا شك أن هذا يؤدي إلى التضامن في
الحيطة والمراقبة والتفقد، وهذا يعسر على الجاني ارتكاب جريمة القتل خاصة، وفي
الوقت ذاته فإنه يدعو إلى التثبت في الشهادة بما يكفل الأمان من الخطأ في حق
المتهم، ولذلك فإن القسامة تؤدي دورا مزدوجا في شأن مكافحة الجريمة الأول يتعلق
بالقاتل الذي يعلم أن ارتكابه للجريمة يترتب عليه – إن لم يكشف عنه – توريطا
للمحلة كلها مما يدعو إلى المزيد من التحري وذلك يؤدي في العادة إلى الكشف عنه
فيحجم على ما أراد فعله، والثاني يتعلق بالأولياء الذين تمنعهم القسامة من اتهام
بغير يقين، فأين نحن اليوم من هذا التشريع و قد أصبحت الجرائم ترتكب و ليس هناك ما
يجبر مشاهديها المفترضين على الإدلاء بشهاداتهم . ثم إن قيمة الأيمان التي تتضمنها
القسامة لا تنفع ما لم يكن أصحابها ممن يعرف قيمة هذه الأيمان وما يترتب على !
الكذب بها، ولا يكون ذلك إلا في مجتمع مؤمن يتقي الله ويخشى عذابه، ولذلك رفض
أولياء عبد الله بن سهل أيمان اليهود في القسامة، واضطر النبي – صلى الله عليه
وسلم – إلى أن وداه . وكأن القسامة شرعت عقابا لمن وجد القتيل بينهم بسبب تقصيرهم
في منع الجريمة، أو في الكشف عن القاتل، ويقول الكاساني في بيان السبب في وجود
القسامة : سبب وجوبها هو التقصير في النصرة وحفظ الموضع الذي وجد فيه القتيل ممن
وجبت عليه النصرة والحفظ، فلما لم يحفظ مع القدرة على الحفظ صار مقصرا بترك الحفظ
الواجب، فيؤاخذ بالتقصير، زجرا عن ذلك، وحملا على تحصيل الواجب، وكل من كان أخص
بالنصرة والحفظ كان أولى بتحمل القسامة والدية، لأنه أولى بالحفظ، فكان التقصير
منه أبلغ، ولأنه إذا اختص بالموضع ملكا أو يدا بالتصرف، كانت منفعته له، فكانت
النصرة عليـه، إذ الخراج بالضمـان كما جاء على لسان . رسول الله – صلى الله عليه
وسلم - (23)،
وقال تبارك وتعالى : ( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
)(24)، ولأن القتيل إذا وجد في موضع اختص به واحد،
أو جماعة إما بالملك أو باليد، وهو التصرف فيه، فيتهمون بالقتل، فالشرع ألزمهم
بالقسامة دفعا للتهمة، والدية لوجود القتيل بينهم، وإلى هذا المعنى أشار عمر رضي
الله عنه – حينما قيل له : أنبذل أيماننا و أموالنا ؟ فقال – رضي الله عنه - : أما أيمانكم فلحقن دمائكم، وأما أموالكم فلوجود القتيل بين ظهرانيكم (25).
5- واجب المجتمع :أشركت الشريعة الإسلامية المجتمع كله في الإصلاح عموما بما في ذلك مكافحة
الجريمة، ليؤدي المجتمع بذلك الدور الذي يعجز عنه الفرد مع نفسه أو الأسرة مع
أفرادها، فالمجتمع لا يخلو من ضعاف النفوس والضمائر الذين لا ينتفعون بالإيمان
والعبادات، كما أن فيه أولياء مهملين لتربية أبنائهم وتنشئتهم بما يقيهم المزا لق
المؤدية إلى الجريمة، فلم يبق لهؤلاء من حاجز يحول بينهم وبين ارتكاب الجريمة سوى
المجتمع، والمجتمع الذي يريده الإسلام هو المجتمع الذي يسود فيه رأي عام فاضل، لا
يظهر فيه الشر ويكون فيه الخير بينا واضحا معلنا، ولذلك دعت الشريعة إلى الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر، واعتبر الإسلام البريء مسؤولا عن السقيم إن رأى فيه
اعوجاجا وكان قادرا على تقويمه فعليه أن يفعل، وأن يقومه بلسانه وهدايته ودعوته
إلى الخير من غير عنف ولا غلظة، بل يدعوه بالتي! هي أحسن ...(26).
وقد أوجب الإسلام تغيير
المنكر على كل أفراد المجتمع، كل حسب طاقته، وهو فرض على الكفاية ويصير فرض عين
على القادر الذي لم يقم به غيره ، يدل على الوجوب قوله تعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
)(27)، وورد في الحديث الشريف قوله – صلى الله عليه
وسلم - : < من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم
يستطع فبلسانه، فإن ل! م يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان>(28). وقد ربط الإسلام هذا الواجب بحقيقة المسلم الكبرى وهي الإيمان، وهي أكثر
حثا للمؤمن على الفعل من العقاب، والكثير من الفتن القائمة اليوم في بعض البلاد
الإسلامية سببها وجود منكرات شرعية يحميها القانون وذلك يتعارض بوضوح مع واجب
تغيير المنكر الذي يستشعره المؤمن، بينما لا نجد ذلك عند غير المسلمين، فحتى ولو
وجدت عندهم منكرات اجتماعية أو عقائدية فليس عندهم ما يدفع إلى تغييرها وإزالتها
كما هو الشأن في الإسلام . ولم يكتف الإسلام بهذا الأمر العام لكل الناس، بل أمر
القرآن نفسه بإنشاء جماعة مكلفة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بنص قوله
تعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون )(29).
وقد أنشأ المسلمون بعد
ذلك ما يعرف بالحسبة والمحتسب، ووظيفة المحتسب هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم، وكثير من الأمور الدينية هو
مشترك بين ولاة الأمور فمن أدى فيه الواجب وجبت طاعته فيه (30).
إن دور المجتمع
بصفة عامة والمحتسب بصفة خاصة هو دور وقائي لا يمنع وقوع الجرائم فحسب بل يمنع
أيضا ما لا يرقى إلى مستوى الجرائم من مختلف المنكرات التي كثيراً ما تكون نهايتها
جرائم، فكم من منكر صغير يتحول اليوم إلى جريمة كبيرة، فرب معاكسة شاب لفتاة تنتهي
إلى جريمتين، جريمة الزنا وجريمة القتل، وقد أثبتت الإحصائيات أن نسبة هامة من
جرائم القتل كان سببها الانتقام للشرف، كما أن ترك الأمر بالمعروف كثيرا ما يؤدي
هو الآخر إلى الجريمة، و كثير من الجرائم يرتكبها أصحابها بدافع من الشعور بالظلم،
فلو كان هناك من أمر بالعدل والإحسان ما وقع كل ذلك.
6- الدور التشريعي :يتجلى هذا الدور في النصوص التشريعية الواردة في القرآن والسنة، وكذلك فيما
اتخذه الخلفاء الراشدون بعد ذلك من قرارات أو ما نطقوا به من أقوال في هذا المجال،
ولن نتحدث في الأسلوب الوقائي عن النصوص التي تتناول العقاب نوعا ومقدارا لأن هذا
لا ينفذ إلا بعد ارتكاب الجريمة وسنراه في الأسلوب العلاجي، وإنما نتحدث هنا عما
وضعته النصوص لمنع وقوع الجريمة ،وذلك هو ما يطلق عليه سد الذرائع، حيث حرم
الإسلام بعض السلوكيات لا لذاتها وإنما لما تفضي إليه من جرائم مثل النهي عن سب
الكافرين لئلا يؤدي ذلك إلى سب الخالق – عز وجل – (
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم )(31)، وفي السياق ذاته جاء نهي النبي – صلى الله عليه وسلم – للرجل أن يلعن والديه، فلما قالوا : كيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : يسب
الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه (32)،فالوقاية
من سب الأب تبدأ من عدم سب آباء الآخرين، وفي مجال الجريمة نجد نصوصا متعددة تمنع
من أمور ليست جرائم في ذاتها ولكن التمادي فيها عادة ما ينتهي إلى جرائم ومن ذلك
الأمر بغض البصر، والنهي عن التبرج لأن ذلك غالبا ما يؤدي إلى جريمة الزنى،وهذه
الجريمة تؤدي إلى الإجهاض والقتل، ومثال ذلك أيض! ا النهي عن إشارة الرجل على أخيه
بالسلاح لأنها ذريعة إلى الإيذاء، حيث و رد في الحديث :
< لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع
في حفرة من النار >(33)وفي هذا المعنى جاء
النهي عن تعاطي السيف مسلولا فقد يخطئ المعطي أو الآخذ فيصاب أحدهما أو غيرهما
بالأذى ،وفي مناولته في قرابه سد لهذه الذريعة (34).
ومن ذلك أيضا نجد حديث : < إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما >(35)لأن وجود خليفتين في وقت واحد مدعاة إلى الشقاق والاختلاف والفتنة والحرب
وضياع نفوس كثيرة ؛ كما أن الإسلام قد نهى عن بيع السلاح في وقت الفتنة لأن ذلك
معين لها ومشجع عليها .
وعن الشعبي قال : بينما
عمر يعس بالمدينة إذ مر بامرأة في بيت وهي تقول :
هل من
سبيل إلى خمر فأشربها أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج
وكان رجلا جميلا . فقال عمر : أما
والله وأنا حي فلا، فلما أصبح بعث إلى نصر بن حجاج فقال له : اخرج من المدينة
فالحق بالبصرة، وفي رواية أنه جز شعره فازداد جمالا فأمره أن يعتم فظل كذلك ثم
نفاه إلى البصرة، ولفساد فيه نفاه والي البصرة أبو موسى الأشعري إلى فارس، وعاود
الكرة هناك فأراد أن ينفيه واليها عثمان بن أبي العاص الثقفي أيضا، فهدد أن يلحق
ببلاد الشرك، فكتبوا إلى عمر، فكتب إليهم عمر أن جزوا شعره، وشمروا قميصه، وألزموه
المسجد(36)،
وقال الإمام علي لما سئل عن عقوبة شارب الخمر : إنه إذا شرب سكر و إذا سكر هذى،
وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة (37). وإذا كان التشريع القرآني قد أخذ بسد الذرائع ورأينا العلة من ذلك فإن
التشريعات الحديثة قد سلكت مسلكا غريبا حيث تبيح الفعل وتعاقب على ما ينتج عنه،
فهي تبيح الزنا مثلا ثم تعاقب على الإجهاض .
يتبع....