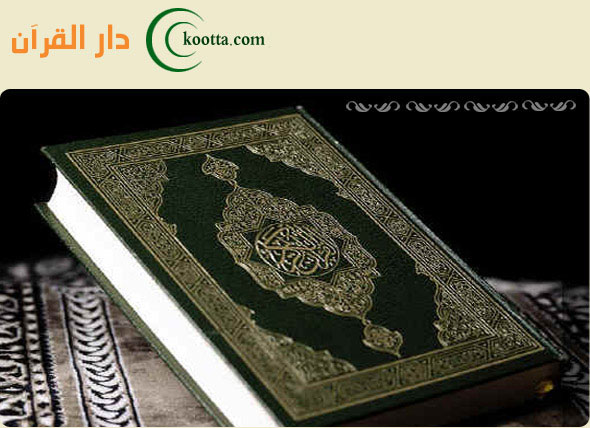ضرْب المثل في غصون الكلام، يعتبر لوناً متميزاً من ألوان التشبيه ويعتبر
أحياناً لوناً خاصاً من ألوان الاستعارة، فإن كان الممثل له مذكوراً في الكلام كان
تشبيهاً، وإن كان محذوفاً فهو استعارة.
وبين المثل الذي يضرب والقصة التي تورد، فارق كبير، وإن كان يجمعهما قدر
مشترك من تنبيه الذهن إلى أخذ العبرة وقياس الحال على الحال.
فالأمثال لا يشترط صحتها على أنها واقعة تاريخية ثابتة: وإنما يشترط فقط
إمكان صحتها أي وقوعها، حتى يتسنى للذهن تصورها كما لو أنها وقعت فعلاً، فمن أجل
ذلك يمكن الربط بين المثال والمعنى الممثل له، حيث يلبس نسيجاً مادياً محسوساً
يتصوره الذهن ويألفه الخيال.
ولكن المثال لا يشترط أيضاً عدم صحتها في نطاق الواقع التاريخي فربما ضرب
المثل بقصة واقعة. وفي القرآن من ذلك كثير. وإنما تسمى القصة عندئذ تمثيلاً، لأنها
سيقت مساق التمثيل بها، ولم تورد على أساس الإخبار عنها.
وفي القرآن نافذة عريضة كبرى على هذه الأمثلة. بل قلّما يخلو معنىً من
المعاني التي يعرضها القرآن، من الاتباط بمثال مقرّب يكسوه ثوباً يُحَسُّ به
ويتجسد فيه.
ولسنا الآن بصدد تحليل القيمة البلاغية لضرب الأمثال، وبيان كيفية
استعمالها والاستفادة منها في أنواع الحديث وأُصول المخاطبات. وإنما الذي يهمنا في
هذا الصدد أن نتلمس أبرز الخصائص التي تظهر في أمثلة القرآن، وعلاقة ذلك ببلاغته
وإعجازه.
ونستطيع أن نوجز هذه الخصائص في الأمور التالية:
أولاً- تعتبر أمثلة القرآن على اختلافها، لوحات فنية رائعة لتصوير
مشاهد الطبيعة بأشكالها وأنواعها المختلفة، وفي هذه اللوحات مشاهد ألِفتها العرب
وعرفتها في حياتها النوعية الخاصة، وفيها ما لم تعرفه ولا رأته ولا سمعت به مما قد
يعرفه بعض الأمم والشعوب الأخرى. فالقرآن إذ يضرب الأمثلة بهذه المشاهد المنتزعة
من مظاهر الكون وصوره، يؤلِّف بين القيم والمبادئ المجردة التي تنزل من أجلها،
والمشاهد الطبيعية التي يعيش الإنسان في أكنافها؛ وفي ذلك من إبراز وحدة الحقائق
الكونية وترابطها الكلي ببعضها ما يطول شرحه ويعظم خطره، وليس لنا في هذه العجالة
سبيل إلى بسط القول في ذلك.
ثانياً- تأخذ الأمثلة في أغلب الأحيان طابع القصة في عرض الجزئيات
وتفصيل صفاتها، وذلك على خلاف المألوف عند العرب من تكثيف المثال وعرضه في أقل قدر
ممكن من الكلمات. فالعرب قد يضربون المثل للشيء الخادع بالسراب، دون تعريج على أيّ
تفصيل في المثال أو بسط لصورته، ولكن القرآن عندما يضرب به المثل يبسط منه صورة
حيّة يتراءى فيها كيف ينخدع الظمآن به، ثم يسعى وراءه، حتى إذا جاءه فوجئ بأنه ليس
شيئاً، ووجد بدلاً عنه ثمرة انخداعه من الجهد الضائع والانقطاع عن الرفقة والطريق:
﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ
كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ
يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ
سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [النور: 39].
ثالثاً- كثيراً ما تأتي أمثلة القرآن كلاماً كاملاً مستقلاً بذاته، أي
دون ذكر للمعنى الممثل له على غرار ما هو معروف في مألوف اللغة العربية وأسلوبها.
وإنما يكون المعنى الممثّل له في هذه الحال مطوياً، يشار إليه في تضاعيف
المثل ذاته، بحيث لا يجهل السامع أو القارئ المعنى الكلي الذي سيق له المثال، وذلك
على غرار الاستعارة وكيفية دلالتها على المعنى الأصلي المقصود.
ولا ريب أن سَوْق المثال بهذا الأسلوب يأتي أبلغ وألصق بالمعنى المراد،
إذا لم يكن في سياق الكلام ما يدعو إلى التصريح به.
فمن هذا القبيل قوله عزّ وجلّ: ﴿وَمَا
يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ
أُجَاجٌ﴾ [غافر:13] فقد ضرب الله مثال البحرين للمؤمن والكافر، والحديث عن
المؤمن والكافر مطوي في تضاعيف المثال، يدلّ عليه السياق.
ومنه أيضاً قوله عزّ وجلّ:
﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا
سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾ [الزمر: 29] فهو مثال للفرق
بين من لم يتخذ مع الله شريكاً فهو لا يبغي الخير ولا يتقي الضرّ من قِبَله، ومن
ثم فهو لا يسعى لإرضاء غيره، ومن اتخذ مع الله شركاء له فقلبه أوزاع بينهم، وهم
فيما بينهم متشاكسون متنافسون على مكاسب الأُلوهية ومقتضياتها، فهو لا يدري بأيّهم
يربط قلبه ولأيّهم يعطي ولاءه!.. ولكن هذا المعنى المقصود مطوي في المثال الذي
ضربه الله تعالى، وهو مثال رجلين أحدهما يتعلق به شركاء متشاكسون متنافسون كلٌّ
يدّعي انفراده بالسلطان الكامل عليه، والآخر موصول الولاء بشخص واحد سلَم له
ومسؤول تجاهه.
ومنه أيضاً قوله عزّ وجلّ: ﴿وَالْبَلَدُ
الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ
إِلاَّ نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾ [العراف: 58].
وغنما هو مثال للقلوب، فقلب سليم يقبل الموعظة والذكرى، وقلب فاسق قاسٍ ينبو عن
ذلك.
هذه أبرز خصائص الأمثال في كتاب الله تعالى.
ولنعرض الآن نماذج مختلفة لهذه الأمثلة، نتلمس من خلالها القيمة البلاغية
التي فيها، وسمة الإعجاز التي تتميز بها، والأسلوب القرآني في تقريب البعيد،
وتجسيد المجردات، وتهويل ما ينبغي تهويله من معاني التهديد والوعيد:
1- يقول الله تعالى في تمثيل حال المنافقين:
﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي
اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ
وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ17/2صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ
يَرْجِعُونَ18/2أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاء فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ
يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ
واللّهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ19/2يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ
كُلَّمَا أَضَاء لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ
وَلَوْ شَاء اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّه عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.
فهما مثالان، يدل كلٌّ منهما في
الجملة على أن شأن المنافق أن يتحلَّى بظاهر من الدين ليكسب منه غنائمه ويتقي
مغارمه، ولكنه يبوء بنهاية تنقلب غنائمه فيها وبالاً عليه، فلا تكسبه خيراً ولا
تحرز له نفعاً.
وانظر كيف يعبّر عن ذلك المثالُ
الأول: إن حالهم أشبه بحال من أشعل ناراً ليستضيء بها، ولكنها ما كادت تضيء ما
حوله وما كاد يطمئن إلى إمكان الاستفادة منها، حتى انطفأت وعاد ما حولها إلى ظلام وبقي
صاحبها يتيه بين الوحشة والحسرة.
وهذا هو معنى المثال الثاني: أو إن حالهم كحال أصحاب مطر غزيرة في ليلة
ظلماء مليئة بوميض البرق وزمجرة الرعد، إذا أومض عليهم البرق كاد أن يتخطف منهم
أبصارهم وإذا داهمهم قصف الرعد جعلوا أصابعهم في آذانهم من مخافته واتقائه. وهم
أثناء ذلك يحاولون أن يستفيدوا من ومضات النور الذي يلمع لهم بين الحين والآخر،
فيسيرون في ضيائه كلما أومض، ويتربصون بأنفسهم كلما أظلم.
أي إنهم متلبسون في ظاهرهم بالإسلام الذي هو كصيِّب من المطر، ولكنهم في
قلق شديد من تبعاته ووظائفه وأحكامه، وعلى طمع من التعلق بمنافعه وخيراته
الدنيوية، فهم لا يزالون كذلك: يسرعون للاستفادة من ثماره كلما لاحت لهم، وينكمشون
أو يتوارون من تبعاته ووظائفه وزواجره كلما أقبلت تواجههم!.
والتمثيل هنا مسوق في تفصيل صوره وأجزائه مساق وصف قصصي كما ترى، وهو من
خصائص أمثلة القرآن كما قد ذكرنا آنفاً. ثم هو مبني على تشبيه مجموعة حالة بمجموع
حالة أخرى دون النظر إلى مقارنة أو تشبيه أجزاء الحالين ببعضهما.
قال الزمخشري في شرح هذين التمثيلين: [والصحيح الذي عليه علماء البيان لا
يتخطونه، أن التمثيلين جميعاً من جملة التمثيلات المركبة دون المفرقة، لا يتكلف
لواحد واحد شيءٌ يقدر شبهه به، وهو القول الفحل والمذهب الجزل. بيانه أن العرب
تأخذ أشياء فرادى معزولاً بعضها عن بعض، لم يأخذ هذا بحجزة ذاك، فتشبهها
بنظائرها.. وتشبه كيفية حاصلة من مجموع أشياء قد تضامَّت وتلاصقت حتى عادت شيئاً
واحداً بأخرى مثلها..].
2- يقول الله عزّ وجلّ: ﴿وَالَّذِينَ
كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى
إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ
حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ * أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ
يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا
فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُلَمْ يَكَدْ يَرَاهَا
وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ﴾ [النور:
39، 40].
يشبه الله تعالى ما قد يبدو انه
مبرور من أعمال الكفار، في عدم فائدته وانقطاع الجدوى منه- إذ كان مؤسساً على باطل
من الكفر بالله عزّ وجلّ- بمثالين اثنين، أحدهما سراب يراه الناظر بالفلاة، وقد
غلبه العطش فيحسبه ماء، حتى إذا أضنى نفسه في المجيء إلى مكانه ضاع عنه ولم يجده شيئاً. ويمزج
البيان الإلهي في آخر هذا التمثيل بين المشبه والمشبه به، أو قل إنه يؤلف بينهما
في الربط بنهاية واحدة، وذلك عندما يقول: ووجد الله عنده فوفّاه حسابه. فقد كان
الحديث إلى ما قبل هذه الجملة عن ظمآن اغترّ بسراب، وفي نهاية المثل اتضح أن الظمآن
لم يكن غير هذا الكافر الذي اغترّ بظاهر أعماله الإنسانية، وراح ينتظر ثمراتها
وآثارها الخيِّرة، حتى إذا جاء يوم الحساب وحانت ساعة القطاف، راعه انه لم يجد
لأعماله الصالحة أثراً، بل وجد بدلاً منها إلهة الذي لم يكن يتوقع أن يراه، ووفاه
حسابه على الحقائق التي كان يبطنها في قلبه لا على المظهر الزائف الذي كان يتجلى
به بين قومه وأصحابه.
أما المثال الثاني فهو بحر هائل بعيد الغور تكاثفت فوقه ظلمات متركمة
تألفت من ظلمة البحر ذاته وظلمة أمواجه العاتية وظلمة السُحُب الداكنة من فوقه؛
فهي ظلمات ثلاث تراكمت بعضها فوق بعضها إلى أن غشيت جو السماء وكاد الرجل أن يضلّ
فيها حتى عن ذاته.
وإنما الظلام في المعنى الممثّل له ظلام الكفر بالله عزّ وجلّ؛ وإنما
القصد أن الكفر إذا حاق بالقلب اصطبغت الأعمال كلها بلونه وتأثرت بظلامه ولم يعد
في شيء منها بصيص ضياء، فهي لا تزيد صاحبها إلا ضلالاً ولا تكسبه إلا مزيداً من
الغواية والخذلان!..
والمثل- كما تعلم- لا يعرفه إلا من يعبر المحيطات من البحارة وأمثالهم،
فهناك يتكاثف مثل هذا الظلام تبعاً لحالات وظروف معينة فهو شيء لا يعرفه سكان
الجزيرة العربية ولا ما حولها. فالتمثيل به ينطوي على دليل من أهم أدلة الإعجاز،
ويؤكد ما ينبغي أن يعلمه كل مسلم من أن هذا الكتاب إنما هو كلام الله عزّ وجلّ، لم
يتدخل في صياغة شيء منه أي بشر من الناس كائناً من كان.
3- قال الله تعالى: ﴿وَاتْلُ
عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ
الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ175/7وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا
وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ
الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ
الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ﴾
[الأعراف: 175- 176].
ضرب الله تعالى هذا النبأ مثلاً لكفار بني إسرائيل، إذ علموا نبوّة سيدنا
محمد صلى الله عليه وسلم حتى إنهم كانوا يستفتحون به على المشركين، فلما جاءهم ما
عرفوا كفروا به.
والنبأ في الآية، نبأ واحدٍ من علماء بني إسرائيل وقيل من الكنعانيين اسمه
بلعام بن باعوراء، أُوتي علم بعض كتب الله تعالى، ولكنه انسلخ منها وركب متن
الضلالة، إذ أخلد إلى متاع الدنيا وفضّل الركون إلى أهوائها وشهواتها.
فلم ينفعه إذ ذاك علمه. وغدا في تعلقه بالدنيا كالكلب يلهث في كل حال إن
جاع أو شبع، إن اهتاج أو تُرك، وهو من أبرز الحيونات التي تُعرف بهذا الشأن. أي
فغدا الرجل يلهث وراء الدنيا ومغانمها في ك حال لا يقعده عن ذلك شبع ولا غنى.
فمثل هؤلاء اليهود في ضلالتهم عن الحق الذي لم يجهلوه، بسبب ميلهم إلى
المغانم الدنيوية، كمثل ذلك الرجل الذي لم ينفعه علمه لما أخلد إلى الدنيا
وأهوائها، بل لم يعد يغنيه امتلاؤه وشبعه عن مواصلة السعي وراءها والانحطاط في
شهواتها.
وهذا المثل- كما ترى- منتزع من قصة واقعة، وليس مجرد فرضية مؤلفة. فهو
مثال وقصة بآنٍ واحد، وإنما عدّدناها في الأمثال لا في القصص لأنها سيقت مساق
المثل، إذ جردت من تفاصيلها القصصية واعتصرت منها معالم العبرة مكثفة موجزة، ولأن
الله سمّاه مثلاً إذ قال في نهاية الآية: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا.
ومن هذا القبيل قوله عزّ وجلّ: ﴿وَاضْرِبْ
لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ
وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا﴾ [الكهف: 31- 42] إلى آخر
قوله تعالى: ﴿وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ﴾.. الآية فهي قصة ذات تفصيل
وأحداث ومراحل، ولكنها سيقت مساق المثل فكانت مثالاً من أمثلة القرآن، وكانت في
الوقت نفسه قصة واقعة يجب التصديق بها.
ومنه أيضاً قوله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّا
بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا
لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ﴾ [ن: 17-32] إلى آخر الآيات. فهي أيضاً قصة واقعة
ولكنها سيقت مساق المثل ولم تورد على أساس مجرد الإخبار عنها.
ولقد اشتهى بعض الكاتبين أن يصطنع اللبس بين المثل الفرضي الذي يورده
القرآن والقصة الواقعية التي يخبر عنها، ثم حلّ المشكلة المصطنعة بأن اعتبر قصص
القرآن كلها مجرد أمثال سيقت للبيان والتقريب، ولم تذكر للحمل على التصديق بما في
مضمونها!..
والحقيقة أنه لا توجد أي لَبْس بين المثال الفرضي والقصة الحقيقية، وما
رأينا عالماً ولا مفسراً ممّن مضى قبلنا أحسّ بشيء من هذا اللَّبْس أو تكلم عنه.
فما من عاقل إلا وهو يدرك أن قصة يوسف، ونوح، ومريم، وعاد،وثمود، ومدين، أخبار
ثابتة لا يلحقها الرَيْب ولا يطولها التأويل، وما من قصة منها إلا ويوجد بين يديها
أو من خلفها ما ينبّه القارئ إلى واقعيتها وصدقها وإلى أنها ليست فرضية من فرضيات
الوهم والخيال، كقوله تعالى: نحن نقصّ عليك نبأهم بالحق. وكقوله: نحن نقصّ عليك
أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وكقوله عزّ وجلّ: ذلك من أنباء الغيب
نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وكقوله تلك من أنباء الغيب
نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.
ولكن الكاتب الذي فعل هذا، شاقه أن يخلد سخافة صاحب «في الشعر والجاهلي» عسى أن
يطبِّل الناس له، كما قد طبّلوا لذاك، سواء جاء ذلك التطبيل ضرباً على القفا أو
صفعاً من الأمام، ما دام أنه تطبيل يذهب بالصيت ويشهره بين عامة الناس.
وبعد، فأحسب أنني لست بحاجة إلى أن أُطيل في عرض النماذج من أمثلة القرآن.
فالاستقصاء عسير، والنموذج يكتفي فيه بأقلَّ مما أوردناه.
والغرض أن تدرك من وراء هذا الذي ذكرناه مدى أهمية الأمثلة في كتاب الله
تعالى، وقد أفردها بالتأليف الإمام أبو الحسن الماوردي (364- 450) وأن تتنبه إلى
أن جانباً كبيراً من الإعجاز القرآني إنما يطلّ من هذه الأمثال من ناحيتي الأسلوب
والمضمون، وأن تعلم بأن المعنى مهما أُلبس ثوباً مطرزاً من البيان والإشراق، فإنه
يظل بعيداً عن مرأى العين والخيال حتى يتجسد في مثال مما يمسّه الحسّ والشعور.
ولأضع أمامك تحقيقاً لهذا الحق وخاتمة لهذا البحث، وهو خلاصة ما قاله
الشيخ عبد القاهر الجرجاني في هذا المقام:
[واعلم أن ما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني أو
أبرزت هي باختصار في معرضه، ونُقلت عن صورها الأصلية إلى صورته، كساها أبَّهة،
وكسبها منقبة، ورفع من أقدارها وشبَّ من نارها.. فإن كان مدحاً كان أبهى وأفخم..
وإن كان اعتذاراً كان إلى القبول أقرب وللقلوب أخلب، وإن كان وعظاً كان أشفى للصدر
وأدعى إلى الفكر..
وإن أردت أن تعرف ذلك، فانظر إلى قول البحتري:
دانٍ على أيدي العفاة وشاسععن كل ندٍّ في الندى
وضريب
كالبدر أفرط في العلو وضوؤه للعصبة السارين جدٌ
قريب
وفكّر في حالك وحال المعنى معك، وأنت في البيت الأول لم تنته إلى الثاني
ولم تتدبر نُصرته إياه وتمثيله له فيما يملي على الإنسان عيناه ويؤدي إليه ناظره،
ثم قِسْهما على الحال وقد وقفت عليه وتأملت طرفيه، فإنك تعلم بُعد ما بين حالتيك،
وشدّة تفاوتهما في تمكّن المعنى لديك، وتحبِّبه إليك، ونبله في نفسك؛ وتوفيره
لأُنسك، وتحكم لي بالصدق فيما قلت، وبالحق فيما ادّعيت].
- من روائع القرآن الكريم: د. محمد سعيد رمضان البوطي.