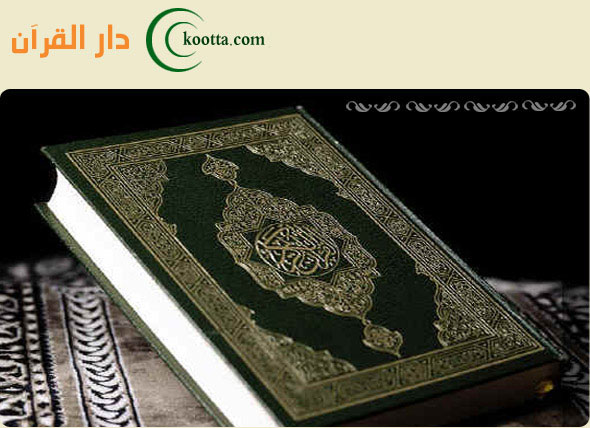* منشأ القراءات:
اعلم أن «القرآن» و«القراءآت» حقيقتان متغايرتان، كما قال الزركشي في كتابه البرهان. أما القرآن فهو هذا اللفظ الموحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز، وأما القراءات فهي ما قد يعتور اللفظ المذكور من أوجه النطق والأداء كالمدّ والقصير والتخفيف والتثقيل وغيرها مما قرأ به الرسول صلى اله عليه وسلم ونقل عنه بالسند الصحيح المتواتر.
وبيان ذلك، أنه لما كتب عثمان المصاحف ووجّهها إلى الأمصار وحملهم على ما فيها، وأمرهم بترك ما خالفها من الأحرف الأخرى التي لا تتفق معها – ترك الناس من قراءاتهم التي كانوا يقرأون بها كل ما خالف خط المصحف، واستمروا يقؤون بسائرها مما لا يخالف الخط وثبتت روايته بالسند المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهذه الأوجه التي استمر الصحابة والتابعون على القراءة بها، بهذا الضابط الذي ذكرنا، هو الجزء الذي بقي من الأحرف السبع، وهو الذي يسمى بالقراءات.
* الحكمة من مشروعيتها:
هي تسهيل واتساع في تلاوة القرآن، اقتضتهما حكمة باهرة أطال في بيانها علماء هذا الشأن، ومردُّ ذلك إلى أمرين اثنين:
الأول: التسهيل على القبائل العربية المختلفة أن تجد الوسيلة إلى قراءة القرآن قراءة صحيحة كما أُنزل دون أيّ تحريف أو تأثم.
الثاني: أن تقف عامّة قبائل العرب وفئاتهم على المعجزة القرآنية من الوجوه المختلفة التي يعرفونها ويمارسون لغتهم بها، وأن ينتصب معنى التحدي أمامهم من هذه الوجوه كلها، فعلى أيّ الأشكال وبأيّ وجوه النطق والأداء أمكنهم أن ينهضوا لمعارضته والإتيان بمثله فلينهضوا ويقدموا.. وبذلك يكون القرآن حجة على أخلاط العرب وفئاتهم كلهم، ويكون معنى التحدّي به قد لزمهم جميعهم.
ما معنى تحديدها بالسبعة ومتى حددت بهذا العدد:
ولم تكن وجوه القراءات التي يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويتلقاها منه أصحابه. محصورة في سبع أو عشر قراءات، بل ربما بلغت أوجه القراءات في مجموعها أكثر من ذلك. وما كان يخطر في بال أحد من الصحابة أن يحصر هذه الوجوه ويجمعها ليحصيها ويقرأ بها كلها ولتكون بذلك فنّاً من فنون القرآن وعلماً مستقلاً من علومه. ولكن الصحابة – وخاصة من اشتهروا بالقراءة منهم – كانوا يتلقون القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم بالأوجه والطرق التي يؤدي بها، فيأخذون عنه ذلك، ثم يقرأ كلُّ منهم بما تيسر له أو اختاره من هذه الوجوه، كما دلّت على ذلك الأحاديث الثابتة الصحيحة.
وقد اشتهر بالقراءة والأقراء من الصحابة عدد كبير، في مقدمتهم: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وأُبيُّ بن كعب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وأبو الدرداء، وأبو موسى الأشعري، فعنهم أخذ كثر من الصحابة والتابعين في الأمصار، وقد اشتهر كل واحد منهم بوجه من أوجه القراءة اختاره ولازمه وأقرأه الناس، فكان يقال: هذه قراءة عبد الله، وهذه قراءة أُبيّ، وهذه قراءة زيد.. إلخ، والكلّ موقن أن سائر الوجوه الأخرى مما لم يأخذ نفسه به ثابت ومنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد ظلّ الأمر هكذا إلى أواسط عهد التابعين: يتلقى الناس القرآن بطريقي الكتابة والمشافهة معاً، ويتلقون من الصحابة الأوجه المختلفة من القراءات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقرأ كلٌّ بالقراءة التي يريدها مما تلقاه بالطريق الثابت الصحيح.
وفي أواخر عهد التابعين، انتبه كثير من علماء القرآن إلى ما أخذ يتسلل إلى الناس من اضطراب السلائق ومظاهر العجمة وبوادر اللحن، كما أوضحنا فيما سبق، فتجرد قوم منهم ونهضوا بأمر القراءات يضبطونها ويحصرونها ويعنون بأسانيدها، كما فعلوا مثل ذلك بالحديث وعلم التفسير.
وقد اشتهر ممّن نهض بذلك أئمة سبعة حازوا ثقة العلماء والقرّاء ف مختلف الأمصار، وإليهم تنسب القراءات السبع اليوم.
وهم: أبو عمرو بن العلاء (ت: 154) وعبد الله بن كثير (ت: 120)وعبد الله بن عامر اليحصبي (ت: 118) وعاصم بن بهدلة الأسدي (ت: 128) وحمزة بن حبيب الزيات (ت: 156) ونافع بن نعيم (ت: 169) وعلي بن حمزة الكسائي (ت: 189).
وليس انحصار الأئمة الذين اعتمدوا إذ ذاك في ضبط القراءات في السبع، دليلاً على أن القراءات المتعددة فيما تعددت القراءة فيه من ألفاظ القرآن – لا تزيد على سبع قراءات. بل القراءات والأوجه التي قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام وتابعة فيها الصحابة ليست محصورة في سبع ولا في عشر كما قد علمت.
ولكن سبب اشتهار هؤلاء السبعة دون غيرهم – كما يقول أبو محمد مكّي وغيره – أن عثمان رضي الله عنه، كتب المصاحف ووجّهها إلى الأمصار، وكان القرّاء في العصر الثاني والثالث كثيري العدد، فأراد الناس أن يقتصروا في العصر الرابع على ما وافق المصحف، فنظروا إلى إمام مشهور بالفقه والأمانة في النقل وحسن الدين وكمال العلم، قد طال عمره واشتهر أمره وأجمع أهل مصر على عدالته، فأفردوا من كل مصر وجّه إليه عثمان مصحفاً، إماماً هذه صفة قراءته على مصحف ذلك المصْر، فكان أبو عمرو من أهل البصرة، وحمزة وعاصم من أهل الكوفة وسوادها، والكسائي من أهل العراق، وابن كثير من أهل مكة، وابن عامر من أهل الشام، ونافع من أهل المدينة، كلهم ممّن اشتهرت إمامتهم وطال عمرهم في الإقراء وارتحل الناس إليهم من البلدان.
* الضابط العلمي لاعتماد القراءات:
وإنما اعتمد العلماء قراءات هؤلاء الأئمة السبعة، بناءً على ضابط علمي كان هو الأساس في قبولهم لها واعتمادهم إيّاها، من أين جاءت وإلى من نسبت.
والضابط هو أن كل قراءة صحّ سندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافقت خط المصحف العثماني ولو احتمالاً، ووافقت العربية بوجه من الوجوه المعتبرة، فتلك هي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردّها ولا يحلّ إنكارها سواء نُقِلت عن الأئمة السبعة أو غيرهم. وما لم تجتمع فيه هذه الشروط الثلاثة فهي شاذة مردودة لا يقرأ بها أيّا كان الإمام الذي نُقِلت عنه.
والمقصود بموافقة القراءة لخط المصحف العثماني ولو احتمالاً، أن تكون أصول الكتابة والرسم التي كتب بها المصحف العثماني مما يحتمل القراءة ويقبلها بوجه من الوجوه ولو تقديراً، كقوله تعالى: ﴿مالك يوم الدين﴾ ففي ﴿مالك﴾ قراءتان: القصر: «ملك» والمدّ «مالك» ورسم المصحف العثماني (ملك) موافق لقراءة القصر تحقيقاً، وموافق لقراءة المدّ تقديراً، إذ المدود وحذفها مما تتحمله أصول الرسم. ومثل ذلك يخادعون ويخدعون في قوله تعالى: ﴿يخادعون الله وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون﴾ فقد قرئ بالمدّ والقصر. ومثل ذلك السين والصاد من ﴿الصراط﴾ فقد قرئ بهما، وكتابة المصحف بالصاد إلا أن الرسم يحتمله: إذ السين والصاد وما بينهما من الإشمام خاضع لرسم واحد تحقيقاً أو تقديراً ذلك لأن هذه الأشكال من النطق بالحرف من فصيلة واحدة.
وبناءً على تمسك العلماء جميعاً بهذا الضابط في قبول القراءة أو رفضها اعتمد العلماء ثلاثة آخرين من أئمة القراءة صحّت قراءاتهم وخضعت لهذا الضابط الذي ذكرناه. وهم: يزيد بن القعقاع أبو جعفر المدني (ت: 132) ويعقوب بن إسحاق الحضرمي (ت: 185) وخلف بن هشام (ت: 229).
فهذه عشر قراءات جميعها صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل العدول الثقات.
ولا يذهبن بك الوهم إلى أن كل إمام من هؤلاء الأئمة العشرة إنما كان يؤمن بقراءة نفسه فقط، ويدعو إليها من دون القراءات الأخرى بل كان كلٌّ منهم يعلم ثبوت سائر القراءات الأخرى كما يعلم ثبوت قراءته ولكنه كان قد أخذ بها وحدها وعكف على خدمتها وتخريج المزيد من أسانيدها.
* الفرق بين القراءات المتواترة والشاذة:
ثم اعلم أن أقل ما تمتاز به هذه القراءات العشر عن القراءات الشاذة التي تأتي من ورائها، هو التواتر والشُهرة. فهذه القراءات السبع ثم الثلاث الأخرى توفر فيها إلى جانب الضابط الذي ذكرنا، التواتر أو الشهرة، وهو أقل ما تفقده القراءات الأخرى.
هذا ولا بدّ أن يكون أصل القراءة الثابتة متواتراً في السند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما كيفيتها ومقاييسها التطبيقية، فقد تقصر عن درجة التواتر، وإن توفرت لها الصحة وأسبابها. وذلك كاختلاف القراءات في تقديرات بعض المدود، فمنهم من أطالها ومنهم من قصرها ومنهم من بالغ في القصر.
وعلى كلٍّ فقد قلنا في صدر هذا البحث إن هنالك فرقاً بين القرآن والقراءات وأوضحنا الفرق إذ ذاك.
فأما القرآن فكله متواتر منقول بواسطة سلسلة متصلة من الجموع التي يؤمَن تواطؤها على الكذب، عن طريق كلٍّ من الكتابة والمشافهة.
وأما القراءات، فما كان منها منضبطاً بالشروط الثلاثة التي ذكرناها فهو ثابت ثبوتاً قاطعاً يُقرأ على أنه قرآن، وهو بين أن يكون متواتراً ومشهوراً، بالإضافة إلى صحته من حيث السند والرواية. وينطبق بذلك على القراءات العشر.
* حكم القراءات الشاذة:
وما لم ينضبط من ذلك بالشروط المذكورة، فهو مردود شاذ مهما كان مصدر نقله ومهما كانت كيفية سنده.
فلا يُقرأ القرآن بشيء من ذلك، في صلاة أو نسك أو تلاوة.
أما العمل بمضمون هذه القراءات الشاذة، فينظر في ذلك إلى سنده فإن توفّر فيه ما يجب توفره في الحديث الآحاد من الشروط الصحة، اعتبر بمثابة الحديث وجاز أخذ الأحكام منه.
وسبب ذلك أن مصدر كثير من القراءات الشاذة أن بعض الصحابة كانوا يهمِّشون مصاحفهم الخاصة، بكلمات تفسيرية لبعض الألفاظ الغامضة إذ كانوا لا يخشون من التباسها بالقرآن بسبب أن عامّتهم كانوا يحفظون القرآن ويضبطونه ضبطاً تاماً، من ذلك تقييد عبد الله بن مسعود آية ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾ بكلمة متتابعات، وتقييد عبد الله بن عباس آية ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ﴾ بكلمة: في موسم الحج.
ثم جاء من بعدهم من نظر في مصاحفهم هذه، ورأى هذه الكلمات التفسيرية فظنها من القراءات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يرويها على أساس ذلك ويتخذ من هذه المصاحف شاهداً له. وإنما هي ألفاظ تفسيرية كما قطع بذلك ابن الأنباري وغيره، أثبتوها مخافة النسيان.
فمثل هذه الألفاظ، وإن كانت ساقطة من حيث اعتبارها قراءة صحيحة، ثابتة من حيث هي تفسير لبعض آيِ القرآن، فهي تُقبل من هذا الوجه، كما يقبل حديث مروي عن ابن عباس بسند صحيح في تفسير آية في القرآن أو استنباط حكم من أحكامه.
* * *
* المصدر:
- من روائع القرآن: د. محمد سعيد رمضان البوطي