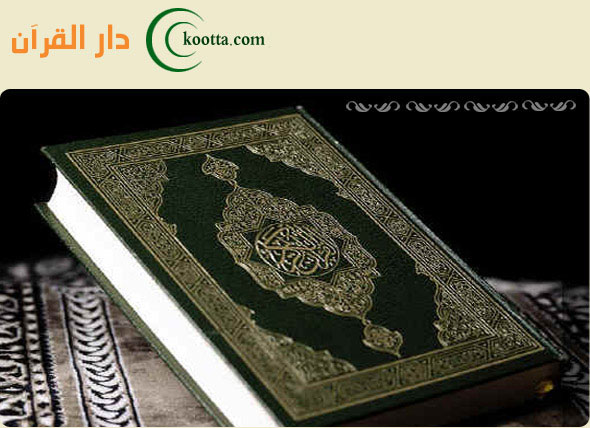ثانياً: التقديم للاختصاص:
قد يتقدم المفعول على فعله أو يتقدم الجار والمجرور أو الظرف والحال ونحو ذلك لأجل فضيلة الاختصاص، وهو "إما بالتعيين في التردد، أو بردّ الخطأ، أي خطأ السامع في تعيين المفعول ونحوه إلى الصواب، وهو المراد من التخصيص، كما في اعتقاد العكس أو الاشتراك كقولك:زيداً عرفت، لمن تردد، إشارة إلى أنه اعتقد أنك عرفت إنساناً، لكن يتردد في تعيين أنك زيداً عرفت أم عمراً، فقولك زيداً عرفت، تعيين وتخصيص، أو لمن أخطأ في اعتقاده، بأن اعتقد أنك عرفت عمراً دون زيد، على عكس عرفانك، فقولك زيداً عرفت، يفيد الاختصاص برد الخطأ، وإذا قلنا الماء شربت لا غيره، فهذا من الاختصاص الذي يشمل قصر القلب والإفراد والتعيين.
تقديم المفعول:
ورد تقديم المفعول على فعله أو فاعله لمزية يقتضيها المعنى المراد بثّه في النفوس ومن ذلك قوله تعالى: (( ساء مثلاً القوم الذين كذّبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون )) ( الأعراف 177 ) فلو جاء السياق مثلاً:كانوا يظلمون أنفسهم لما تحققت مزية تخصيص أنفسهم وحدهم بالظلم، فجأة "تقديم المفعول به للاختصاص كأنه قيل:وخصّوا أنفسهم بالظلم لم يتعدّها إلى غيرها" وهنا إبراز للنفس التي ظلمت وتخيّل لأثره عليها.
ومن ذلك قوله تعالى:(( سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار )) ( إبراهيم 50 )
ففي قوله: ( وجوههم ) مجاز مرسل علاقته الجزئية، حيث ذكر الجزء، وهو الوجوه، ذكر الحاصل هو أن النار تغشى جميع أبدانهم، ولكن في تخصيص ذكر الوجوه وتقديمها لفت للانتباه لما يلحقهم من المهانة والذلة وهم الذين أرادوا الوجاهة والمنزلة في قومهم، ومن قوله:( من قطران ) بيانية أي من هذا الجنس.
تقديم الجار والمجرور:
قد يقع الظرف خبراً، أو يتقدّم الجار الأصلي فيكون خبراً، وحينئذ يشترط في الظرف الواقع خبراً وفي الجار الأصلي مع المجرور كذلك – أن يكون تاماً، أي يحصل بالإخبار به فائدة بمجرد ذكره، ويكمل به المعنى المطلوب من غير خفاء ولا لبس ولابد للظرف أو الجار والمجرور من متعلق حتى تتم الفائدة أو المعنى وإلا لم يكن منهما فائدة... وسوف نقف مع بعض النماذج القرآنية لنرى ما أفاء الله به من أسرار بلاغية لهذا التقديم.
يقول تعالى:(( ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأنّ له نار جهنم خالداً فيها ذلك الخزي العظيم )) ( التوبة 63 )
لقد حملت الآية الكريمة على من يحادد الله ورسوله، فكان الزجر والوعيد الناشئ عن الاستفهام في صدر الآية، وتوكيد الخبر بأنّ واسمية الجملة لأن المنافقين مع علمهم بهذه الحقيقة نزّلوا منزلة من يجهلها وينكرها لعدم جريهم في الاعتقاد والسلوك وفق ما يقتضيه علمهم، وتقديم الخبر ( له ) على اسم ( أن ):( نار جهنم ) لإفادة القصر، أي له لا لغيره، والإفراد في ( له ) و ( خالداً ) مراد به العموم.
ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى:(( قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمنّ على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرنّ على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكّل المتوكّلون )) ( إبراهيم 11-12 )
ففي تقديم الجار والمجرور في لفظة الجلالة ( وعلى الله ) في الآيتين لإفادة القصر والتخصيص أي:التوكل والاعتماد لا يكون إلا على الله لا على غيره... وجاء لفظ المؤمنون في الآية الأولى لأنه أمر من رسلهم للمؤمنين الذين آمنوا بالتوكل على الله وحده، وهذا من علامة الإيمان الصادق... وجاء لفظ ( المتوكلون ) في الآية الثانية ليكون معناه، فليثبت المتوكلون على ما استحدثوا من توكلهم وقصدهم إلى أنفسهم على ما تقدّم.
ومن ذلك أيضاً ما جاء في نفس السورة قوله تعالى:(( وبرزوا لله جميعاً فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص )) ( إبراهيم 21 )
جاء تقديم ( لكم ) على ( تبعاً ) لإفادة التخصيص التبعية لهم وقصرها عليهم دون غيرهم وحبس حياتهم رهن إشارتهم وفيه إظهار مدى ندامتهم وحسرتهم على تلك التبعية لسادتهم الذين لم يستطيعوا أن يدفعوا عنهم ولا عن أنفسهم شيئاً وقد هلك الجميع.
ومما جاء في تخصيص الملك والحمد بالله وحده دون غيره قوله تعالى:(( يسبّح لله ما في السموات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير )) ( التغابن 1 )
وقد وقف ابن الأثير رحمه الله أمام بعض الآيات الواردة في مثل هذه السياقات السابقة ورفض أن تكون للاختصاص، ونعى على من احتسبها كذلك، كتقديم الظرف في قوله تعالى:(( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكّلت وإليه أنيب )) ( الشورى 10 )
(( صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور )) ( الشورى 53 )
(( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة )) ( القيامة 22- 23 )
(( والتفّت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق )) ( القيامة 29 -30 )
فقال ابن الأثير:فإن هذا روعي فيه حسن النظم، لا الاختصاص في تقديم الظرف وفي القرآن مواضع كثيرة من هذا القبيل يقيسها غير العارف بأسرار الفصاحة على مواضع أخرى وردت للاختصاص وليست كذلك.
ولا عجب أن يكون التقديم في تلك الآيات للاختصاص مع إفادة الغرض الذي أشار إليه، لأن المعنى يقتضي ذلك ويتطلبه، فكيف لا نقول أن تقديم ( عليه ) على ( توكلت ) يفيد قصر التوكل على الله لا على غيره ؟! وكذلك الإنابة إليه دون غيره، وهذا من كمال التوحيد ونقاء العقيدة... ولو فرضنا السياق جاء على غير هذا التقديم، وكان مثلاً:توكلت عليه وأنبت إليه، لافتقد السياق مزية حسن النظم، وجلاء المعنى أيضاً فإن الجملة الأخيرة التي تأت على التقديم لتفيد أن التوكل عليه وعلى غيره أو الإنابة إليه ولا يمنع أن تكون إلى غيره ! ولكن بالتقديم سدت جميع الأبواب وقصرت التوكّل على الله وحده والإنابة إليه وحده دون غيره.
وفي آية الغاشية التي رفض ابن الأثير جعلها للاختصاص، وقد ناقض نفسه بقوله:أي تنظر إلى ربها دون غيره، فتقديم الظرف هنا ليس للاختصاص!!!
فكيف لا يكون تقديم الظرف للاختصاص، وهو يقول تنظر إلى ربها دون غيره !! ويقول الزمخشري:ألا ترى إلى قوله تعالى:(( إلى ربك يومئذ المستقر )) (( إلى ربك يومئذ المساق )) (( إلى الله تصير الأمور )) (( وإلى الله المصير )) (( وإليه ترجعون )) (( عليه توكلت وإليه أنيب ))، كيف دلّ فيها التقديم على معنى الاختصاص.
ومما جاء في التقديم لإفادة التخصيص ورعاية الفاصلة، قوله تعالى:(( بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزّل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين )) ( البقرة 90 )
(( ومن يعص الله ورسوله ويتعدّ حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ))
ومنه أيضاً قوله تعالى:(( ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاؤوهم بالبيّنات فانتقمنا من الّذين أجرموا وكان حقاً علينا نصر المؤمنين )) ( الروم 47 )
فتقديم التوكيد ( حقاً ) وتقديم خبر كان ( علينا ) لإشعار المؤمنين بالنصر المحقق الذي لا مرية فيه وفي هذا ترسيخ للعقيدة وحسن التوكّل على الله والثقة فيه لا في غيره، عندما يشعر المؤمن بأن النصر مختص بالله مقصور عليه سبحانه.
ثالثاً:التقديم بين الآية والآية:
في هذه الوقفة نرى أسراراً أخرى لأسلوب التقديم مغايرة للمواضيع السابقة، والمقصود بهذا التقديم الذي يأتي بين الآية والآية هو ما ننظر إليه من حيث تقديم صيغة على أخرى في بعض آيات السورة الواحدة، أو تقديم آية على آية في النزول، أو تقديم موضع على آخر في السورة الواحدة، أو التقديم والتأخير في المتشابه.
أولاً:تقديم صيغة على أخرى في بعض آيات السورة الواحدة:
وقد ورد ذلك في بعض المواضع من آيات الذكر الحكيم لعلة يقتضيها السياق ويتطلّبها المعنى، وذلك نحو قوله تعالى:(( يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحبّ كلّ كفّار أثيم )) ( البقرة 276)
وقوله تعالى:(( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم )) (البقرة 283 )
فقد وردت الصيغتان في الآيتين وهما:أثيم – آثم، وتقدّمت الصيغة الأولى على الثانية للفارق المعنوي بينهما، فـ ( أثيم ) صفة مشبّهة باسم الفاعل، وهي صيغة مبالغة تفيد الإقامة على فعل ذلك الإثم والإصرار عليه والتمعّن فيه بلامبالاة، وأثيم:من قوم أثماء، والأثيم:الفاجر.
فقد وردت صيغة ( أثيم ) في سياق الحديث عن الربا ومحقه والنفير منه، قال الزمخشري في قوله تعالى:( كل كفار أثيم ) تغليظ في أمر الربا وإيذان بأنه من فعل الكفار ( قوم أثماء ) لا من فعل المسلمين.
أما الآية الأخرى فقد وردت في سياق النهي عن كتمان الشهادة (( ولا تكتموا الشهادة )) ثم الوعيد من التهديد عن طريق أسلوب الشرط (( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ))... وكتمان الشهادة أقل جرماً من تعاطي الربا وممارسته الذي يتأذى منه المجتمع كله، بينما تأتي ثمرة كتمان الشهادة المرّة على الأفراد... وقد أسند الإثم إلى القلب لأن كتمان الشهادة ( هو أن يضمرها ولا يتكلّم بها، فلما كان إنما مقترفاً بالقلب أسند إليه، لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ، ألا تراك تقول إذا أردت التوكيد:هذا مما أبصرته عيني، ومما سمعته أذني، ومما عرفه قلبي، ولأن القلب هو رئيس الأعضاء والمضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله، فكأنه قيل:قد تمكّن الإثم في أصل نفسه وملك أشرف مكان فيه.
ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى:(( قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرّعاً وخفية لئن أنجانا من هذه لنكوننّ من الشاهدين )) ( الأنعام 63 )
وقوله:(( قل الله ينجيكم منها ومن كلّ كرب ثم أنتم تشركون )) ( الأنعام 64 )
وقد وردت صيغتان في الآية الكريمة:ينجيكم – أنجانا، وقدّم الأولى على الثانية لاقتضاء المعنى الذي ينتقي الألفاظ ويحددها، فإن الألفاظ في القرآن نزلت من لدن القدرة الإلهية معبّرة عن معانيها الدقيقة، فإذا وردت مادة بصيغتين أو أكثر، فليس ذلك فراراً من التكرار، وإنما يحدث لأن كل صيغة تعبّر عن معنى لا تعبّر عنه الصيغة الأخرى، مهما تقاربتا.
فالصيغة الأولى التي جاءت بالتشديد ( ينجيكم ) إنما جاءت في جناب الله وحقه، وجاءت في صيغة الاستفهام المجاب عنه في الآية التي تلتها مباشرة ( قل الله ينجيكم ) فهي نجاة بالغة العظمة والقدرة، وهي تستمر نجاة بعد نجاة... أما الصيغة الثانية فقد كانت دعاء منهم، وكانت ( أنجى ) دالة على قلّة احتمال حدوث النجاة، فقد سبقها ( لئن ) تأتي لتقليل حدوث فعل الشرط ولهذا بالغوا في جواب ( لئن) عن طريق التوكيد باللام ونون التوكيد الثقيلة:( لنكونن ) رغبة في تقوية حدوث فعل الشرط الذي تتوقف على حدوثه حياتهم.
ومن ذلك ما جاء أيضاً في سورة غافر في قوله تعالى:
(( وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربّي الله وقد جاءكم بالبيّنات من ربكم وإن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذّاب )) ( غافر 28 )
فقدّمت صيغة اسم الفاعل ( كاذباً ) على صيغة المبالغة ( كذّاب ) فالأولى، وقعت في سياق يوحي بانتفاء الكذب من أصله لتقديم قوله:(( وقد جاءكم بالبيّنات من ربكم )) فكيف بمن جاء بالبيّنات من رهب أن يكون متّصفاً ولو أدنى اتصاف بالكذب ؟! ولذلك جاءت الصيغة ( كاذباً ) في سياق ( إن ) الشرطية مع حذف النون من ( يك ) فلم يقل يكن وهو الأصل ليشعر بانتفاء ذلك، هذا بالإضافة إلى تنكير (كذبا ) في سياق الشرط لإفادة العموم، أي:وإن يك كاذباً ما، يعني إن وُجد ذلك من أصله.
أما صيغة ( كذّاب ) فهي لإفادة المبالغة كما سبق ذكره، وهي ترسم صورة لهذا الذي يمارس الكذب ويتعاطاه في كل أحوال حياته، حتى استحقّ تعريفه بالمسرف، وعدم الهداية من الله ( إن الله لا يهدي من هو مسرف كذّاب )
ومن ذلك أيضاً ما جاء في سورة التحريم في قوله تعالى:(( وإذ أسرّ النبي إلى بعض أزواجه حديثاً فلمّا نبّأت به وأظهره الله عليه عرّف بعضه وأعرض عن بعض فلمّا نبّأها به قالت من أنبأك هذا قال نبّأني العليم الخبير )) ( التحريم 3 ).
فجاءت صيغة ( نبّأها ) متقدمة على ( أنبأك ) ثم أعديت صيغة ( نبّأني ) مرة أخرى، لأنّ الصيغتين ( نبأ ) في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينبّئ به فهو حق اليقين لأنه لا ينطق عن الهوى، و ( من أنبأك ) حكاية عن كلام أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، وهي لم تبلغ مبلغ يقين الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الراغب الأصفهاني: نبّأته أبلغ من أنبأته (( فلننبئنّ الذين كفروا – ينبّؤ الإنسان يومئذ بما قدّم وأخّر)) ويدلّ على ذلك قوله تعالى:(( فلما نبّأها به قالت من أنبأك هذا قال نبّأني العليم الخبير )) ولم يقل أنبأني بل عدل إلى نبأ الذي هو أبلغ تنبيهاً على تحقيقها وكونه من قبل الله.
ومن ذلك أيضاً ما جاء بصيغة المبني للمجهول سابقاً ومتقدّماً على المبني للمعلوم خلافاً للمعهود وذلك في قوله تعالى:(( ويطاف عليهم بآنية من فضّة وأكواب كانت قواريراً قوارير من فضّة قدّروها تقديراً )) ( الإنسان 15 -16 )
وقوله تعالى:(( ويطوف عليهم ولدان مخلّدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً )) ( الإنسان 19 )
قال الكرماني: إنما ذكر الأول بلفظ المجهول لأن المقصود ما يطاف به لا الطائفون، ولهذا قال:( بآنية من فضة ) ثم ذكر الطائفين فقال:( ويطوف عليهم ولدان مخلّدون ) فالصيغة الأولى جاءت بالبناء للمجهول لأن الفاعل غير مراد، ولكن المراد تسليط الضوء ولفت الذهن إلى النعم المتعددة في السياق، فإذا انتهى من تعداد ذلك، كان لائقاً التعقيب بذكر هؤلاء الغلمان الذين يقومون بخدمة المؤمنين ويقدّمون لهم ما يقدّم من ألوان هذه النعم التي ذكرت من قبل، وإنه لمن المعقول حقاً أن يتقدّم تعداد النعم على من يقومون بتقديمها.
ومن ذلك أيضاً ما جاء مقدّماً بالتضعيف على وزن ( فعّل ) على الفعل المهموز على وزن أفعل، يقول تعالى:(( فمهّل الكافرين أمهلهم رويداً )) ( الطارق 17 )
وقد نصّ الكرماني على أن ذلك ليس من التكرار، والتقدير:مهّل، مهل لكنه عدل في الثاني إلى قوله:أمهل كراهة التكرار وخالفة الزمخشري واعتبره من التكرار، فقال:أي إمهالاً يسيراً، وكرّر وخالف بين اللفظين لزيادة التسكين منه والتبصّير.
أي:في ذلك إشاعة جو من الطمأنينة والسكينة في قلب النبي وقلب المؤمنين ليثبتوا مع النبي ويصبروا على أذى الكافرين... وهذا وإذا كان ختام السورة بهذا التكرار المؤدى للتوكيد، فإن فيه اتفاق واتساق مع بداية السورة بالقسم المفيد للتوكيد أيضاً ثم بتكرار كلمة الطارق التي أشاعت جرساً قويّ الإيقاع في جو المشهد.
ثانياً: تقديم آية على أخرى في النزول:
من المعلوم أن من الآيات ما نزل لسبب من الأسباب أو لمعالجة موقف من المواقف التي وقعت في حياة المسلمين ومنها ما نزل لإثبات حكم شرعي أراده الله لصالح الحياة والممات.. وكانت هذه الآيات تناسب أحوال الناس وعمر الدعوة الإسلامية فيهم ومدى صلابة العقيدة في ذلك الوقت، فما نزل بمكّة يختلف في الأحكام والشرائع عمّا نزل بالمدينة، فإن من أسرار القرآن أنه يمسك بأحوال النفس الإنسانية كلها، ويجيء إليها بما يناسب كل حال منها في مواجهتها للأحداث وفي تصورها لها وإحساسها بها.
وإذا نظرنا إلى أوّل ما نزل من القرآن الكريم فسنجد قوله تعالى:(( اقرأ باسم ربّك الذي خلق، خلق الإنسان من علق )) ( العلق 1-2 )
فجاء الخبر بأن الله خلق الإنسان من علق، والعلقة ( الدم الجامد ). وإذا جرى فهو الدم المسفوح وقال:( من علق ) بجمع علق، لأن المراد بالإنسان الجنس، وإذا كان المراد بقوله:( الذي خلق ) كل المخلوقات، فيكون تخصيص الإنسان بالذكر تشريفاً له، وإذا كان المراد بالذي خلق:الذي خلق الإنسان، فيكون الثاني تفسيراً للأول، والنكتة ما في الإبهام ثم التفسير، من التفات الذهن وتطلّعه إلى معرفة ما أبهم أولاً، ثم فسّر ثانياً.
وهذه الآية مكّية وقد تقدّمت في النزول على آية سورة المؤمنون وهي مكّية أيضاً وذلك في قوله تعالى:(( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين )) ( المؤمنون 12-14 )
والعلّة في ذلك والله تعالى أعلم أن آية العلق كانت في بداية ظهور الإسلام وأولى نسائمه ولم تكن النفوس مهيّئة لاستقبال الأمر المفصّل أو الشرح المطوّل بدقائقه، فأجمل لكي يمسّ القلب ويطرقه طرقاً خفيفاً يوقظ الذهن من غفوته وغفلته، ثم جاء بعد ذلك التفصيل ووصف المراحل الدقيقة في سورة المؤمنون بعدها تهيّأت النفوس لذلك واستعدّت لاستقباله وفهمه.
ومن ذلك أيضاً ما جاء من الآيات مقدّماً بعضه على بعض في تحريم شرب الخمر، وذلك مراعاة لمقتضى الحالة التي كان عليها المسلمون من شربها في ذلك الوقت، فلم يكن سهلاً أن ينقلهم الإسلام فجأة من المألوف إلى التحريم، فنزلت الآيات بالتدرّج في مراحل التحريم، فتقدّمت أولاً آية بيان الإثم الأكبر والمنافع الأقل للخمر، فأصبح التنفير واقعاً في النفس، يقول تعالى:(( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبيّن الله لكم الآيات لعلّكم تتفكّرون )) ( البقرة 219 )
ثم نزل في مراحل ثانية قوله تعالى:(( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلّا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوّاً غفوراً )) ( النساء 43 )
فانتقل المسلمون مع هذه الآية نقلة ثانية تالية للمرحلة الأولى، فصاروا يتجنبون شربها في النهار الجامع لأطراف الصلاة، حتى أصبح الوقت المباح لشربها هو الليل وقليل فاعله، ثم كانت المرحلة الأخيرة التي أتمّ الله تعالى فيها التحريم القاطع إلى يوم الدين، قال تعالى:(( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون )) ( المائدة 90 ) فهم في هذه المرحلة كانوا على أتم الاستعداد النفسي والجسدي لاستقبال هذا الأمر وتنفيذه من فوره دون معاناة أو تملل.
صورة أخرى متكاملة تحمل أجزاء المشهد الواحد لو ضُم بعضه إلى بعض، ولكنه يبدأ بأخف المراحل فيقدّمها أولاً ثمّ يتدرّج إلى الأشدّ حتى يبلغ الغاية ويفي بها... إن ذاك مع عصا موسى عليه السلام، يقول تعالى:(( قال هي عصاي أتوكّأ عليها وأهشّ بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حيّة تسعى )) ( طه 18-20 )، ويقول تعالى:(( وألق عصاك فلما رآها تهتزّ كأنها جانّ ولّى مدبراً ولم يعقب يا موسى لا تخف إنّي لا يخاف لديّ المرسلون )) ( النمل 10 )
ويقول تعالى:(( وأن ألق عصاك فلما رآها تهتزّ كأنها جانّ ولّى مدبراً ولم يعقّب يا موسى أقبل ولا تخف إنّك من الآمنين )) ( القصص 31 )
ويقول تعالى:(( فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين )) ( الأعراف 107 ) ويقول تعالى:(( فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين )) ( الشعراء 32 )
ونفهم من هذا الترتيب أن أول اختبار لموسى مع العصا أنها ظهرت له في صورة ( حيّة تسعى ) فوقع في نفسه ما وقع من خوف... ثم جاء الاختبار الثاني في سورة النمل وهي متأخرة نزولاً عن سورة طه وفيها تظهر العصا حيّة في ضخامتها وجاناً في انطلاقها واقتضاها ولهذا لم يخف مجرد خوف كما فعل حين واجه الحية ولكنه ولى مدبراً ولم يعقب.
أما الصورة الثالثة فهي تحوّل العصا إلى ثعبان مبين، وهذا المشهد قد وصل إلى ذروته لأن مشهد إلقاء العصا يغاير المشهدين السابقين الذين كانا على سبيل الإعداد والتجهيز النفسي.. أما المشهد الثالث فهو مشهد الواقعة والتحدي، فكانت الصورة التي جمعت بين الحية والجان في كيان واحد قد برزت كاملة في قوله تعالى:فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ثعبان لا كالثعابين... وإنما هو ثعبان عظيم... فيه خفّة الثعبان ونشاطه وعظم الحية وضخامتها... وفي كلا الموضعين تقع الصورة التي تجيء عليها المعجزة على حال واحدة... ولهذا جاء النظم القرآني لهما على سواء.
(فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين في سورتي) الأعراف و(فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين في سورتي) الشعراء.
تقديم موضوع على آخر في السورة الواحدة:
اختلف العلماء في ترتيب سور القرآن هل هو توقيفي أو باجتهاد الصحابة، وكان جمهور العلماء على أنه ليس توقيفياً بل هو من اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم أما الآيات فقد كان الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك، وقال عثمان رضي الله عنه كان رسول الله تنزل عليه السورة ذات العدد فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول:(ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ).
ومعظم السور القرآنية قد اشتملت على موضوعات متعددة كالسبع الطوال والمئين والمثاني والمفصل... وهذه الآيات الموضوعية قد تقدّم بعضها على بعض بتوقيف من الله عز وجل وتظهر في ذلك نكتة بلاغية، نتبينها في المثال الآتي، ألا وهو سورة البقرة وهي على طولها ووضوح تفصيلها تتكون مما يأتي.:
المقدمة:الآيات ( 1-20 )
وهي في التعريف بشأن هذا القرآن ( أي في هذه السورة ) وبيان أن ما فيه من الهداية قد بلغ حداً من الوضوح لا يتردد فيه ذو قلب سليم.
المقصد الأول: الآيات ( 21 -25 )
وجاء في دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام ثم عود على بدء في أربع عشرة آية من ( 26 -39 )
المقصد الثاني: الآيات ( 40 -126 )
في دعوة أهل الكتاب دعوة خاصة إلى ترك باطلهم والدخول في هذا الدين الحق وعلى ذلك مدخل إلى المقصد الثالث في خمس عشرة آية من ( 163 – 177 )
المقصد الثالث: الآيات من ( 178- 283 )
في عرض شرائع هذا الدين تفصيلاً
المقصد الرابع:في آية واحدة 284
ذكر الوازع والنازع الديني الذي يبعث على ملازمة تلك الشرائع
الخاتمة:في آيتين اثنتين ( 285 – 286 )
وهي في التعريف بالذين استجابوا لهذه الدعوة الشاملة لتلك المقاصد، وبيان ما يرجى لهم إنها كالبناء الشامخ الذي يبدأ فيه بإقامة الأساس من جذوره، ثم إقامة البنيان وتشييده ثم زركشته وتزيينه.
فهذا الترتيب للموضوعات في داخل السورة لهو كالحلقات المتشابكة يشدّ بعضها بعضاً ويؤدي كل موضوع إلى أخيه في تسلم رائق، يمهّد له ويبسط ضوءه رويداً حتى يلقى بدره من الأعماق... ماذا لو جاء موضوع منها قبل الآخر ؟! ما نرى إلا اختلال ميزان الفكر وتشتت الوجدان والشعور !!
وقوفاً مع سورة أخرى، هي سورة النور وهي مدنية وآياتها أربع وستون آية.. وهي في الآداب الاجتماعية والتربية والنورانية التي تشع بنورها في البيت والأسرة والمجتمع.
ويجري سياق السورة حول محورها الأصيل – التربية – في خمس أشواط
· الأول: يتضمن الإعلان الحاسم الذي تبدأ به، ويليه بيان حدّ الزنا، ثم بيان حدّ القذف، ثم حديث الإفك.
· الثاني: وسائل الوقاية من الجريمة وتجنيب النفوس أسباب الإغراء والغواية فيبدأ بآداب البيوت والاستئذان على أهلها والأمر بغض البصر والنهي عن إبداء الزينة، والحض على إنكاح الأيامى والتحذير من دفع الفتيات إلى البغاء.
· الثالث: يتوسّط مجموعة من الآداب التي تتضمّنها السورة فيربطها بنور الله، ويتحدّث عن أطهر البيوت، وفي الجانب المقابل الذين كفروا وأعمالهم... ثم يكشف عن فيوض الله في الآفاق.
· الرابع: يتحدث عن مجافاة المنافقين للأدب الواجب مع رسول الله ويصوّر أدب المؤمنين.
· الخامس: آداب الاستئذان والضيافة في محيط البيوت وآداب الجماعة المسلمة كلها كأسرة واحدة.
فيعجب المتأمّل من هذا الترتيب المنطقي البديع الذي بدأ أولاً بتطهير المجتمع من الجريمة ووضع العقاب والزجر ليرتدع المجرم، وقدّم ذلك على عرض وسائل الوقاية لتتهيّأ النفس لاستقبال تلك الآداب الوقائية بنفس هادئة وتقبل على أساليبها بحب ممتزج بالخوف من الله، وهذان الموضوعان لازمان للدخول في الحديث عن آداب آخرى يربطها بنور الله
ثم تصوير للآداب المفقودة في حق المنافقين فتقدم على تصوير آداب المؤمنين فبدأ من الأدنى للتنفير منه، ثم للأعلى ليشحذ الهمم وتنشط النفس وترغيبها بعد ترهيبها.
يتقدّم تنظيم العلاقات الأسرية الصغيرة داخل البيوت، لأن ذلك هو النواة والأساس الذي ينى عليه بعد ذلك تنظيم العلاقات بين الأسرة الكبيرة في المجتمع المسلم ككل... فيتقدّم قوله تعالى:(( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوّافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبيّن الله لكم الآيات والله عليم حكيم )) ( النور 58 ) وهي الأسرة الصغيرة، على قوله تعالى:(( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم )) ( النور 62 ) (وهي الأسرة الكبير ).
وفي وسط هذه الآداب تأتي استراحة قصيرة – إن صح التعبير – ليمضي السياق في عرض مشاهد الكون ومظاهر الوجود الجميل والتأمّل في تقلّب الليل والنهار وعرض مظاهر القدرة على الخلق والتنويع في أشكال الخلق ( وذلك في الآيات من 41 – 45 ) لتتوسط هذه الوقفة الكونية ما سبقها من آداب وتعاليم وما لحقها من آداب وتعاليم، فهذه السورة نموذج من ذلك التنسيق، لقد تضمّنت بعض الحدود إلى جانب الاستئذان على البيوت، وإلى جانبها جولة ضخمة في مجال الوجود، ثم عاد السياق يتحدث عن حسن أدب المسلمين في التحاكم إلى الله ورسوله وسوء أدب المنافقين إلى جانب وعد الله الحق للؤمنين بالاستخلاف والأمن والتمكين، وها هو ذا يعود إلى آداب الاستئذان في داخل البيوت إلى جانب الاستئذان من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظم علاقة الزيارة والطعام بين الأقارب والأصدقاء إلى جانب الأدب الواجب في خطاب الرسول ودعائه.
التقديم والتأخير في المتشابه:
قد تأتي بعض الآيات متشابهة في كلماتها ولكننا نجد كلمة قدمت في آية وأخرت في أخرى لسر بلاغي أودعه الله في السياق، وسوف نقف – بإذن الله وتوفيقه – مع بعض هذه النماذج القرآنية التي وردت عبر السور المختلفة.. ومن ذلك قوله تعالى:(( واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون )) ( البقرة 123 )
فالآيتان من مشاهد القيامة وساحة القضاء الأعلى، وقد سُبقت الآيتان بآية تامة التشابه متحدة الكلمات وانتظامها، وهي قوله تعالى:(( يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنّي فضّلتكم على العالمين )) ( البقرة 47 ) (( يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنّي فضّلتكم على العالمين )) ( البقرة 122 )
وهذا التكرار للحثّ على التذكّر للنعمة والتحذير من الإعراض عن الله ورسوله، فاليهود أمّة جبلت على العناد والتّمرّد وذلك على الرغم من أنّهم أكثر الأمم رسلاً وأنبياء، وقدّم الشفاعة في السياق الأوّل ( آية 48 ) قطعاً لطمع من زعم أن آباءهم تشفع لهم، وأن الأصنام شفعاؤهم عند الله، وأخّرها في الآية الأخرى ( 123 ) لأن التقدير في الآيتين معاً لا يقبل منها شفاعة فتنفعها تلك الشفاعة، لأن النفع بعد القبول، وقدم العدل في الآية الأخرى ليكون لفظ القبول مقدّماً فيها.
ومما يشدّ من أزر ذلك المعنى الذي يبرز قطع الأمل في تلك الشفاعة، أنه جاء بـ ( يوماً ) على التنكير للتهويل ودفع النفس نحو الخوف والحذر، ونكر النفس مرتين للدلالة على العموم والشمول لكل نفس، وهو الإقناط الكلي القاطع للمطامع، وقد جاء بالفعل ( يُقبل ) مع ( شفاعة ) لأنها محلّ القبول على سبيل الرحمة والرأفة، وجيء بالفعل ( يؤخذ) مع ( عدل ) لأن ذلك على سبيل الفداء ومن ذلك قوله تعالى:(( وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطّةٌ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين )) ( البقرة 58 )
وقوله تعالى:(( وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وادخلوا منها حيث شئتم وقولوا حطةٌ وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين )) ( الأعراف 161 )
ففي الآية الأولى:(( وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطةٌ )) وفي الآية الثانية ( وقولوا حطةٌ وادخلوا الباب سجداً ))
وقف الزمخشري على هذا الاختلاف على استحياء ولم يشأ الدخول في غماره وأعماقه، فاكتفى بقوله:لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هناك تناقض، ولا تناقض بين قوله ( اسكنوا هذه القرية وكلوا منها ) وبين قوله ( فكلوا) لأنهم إذا سكنوا القرية فتسببت سكناهم للأكل منها، وسواء قدّموا الحطة على دخول الباب أو أخروها فهم جامعون في الإيجاد بينهم، وترك الرغد لا يناقض إثباته.
والحق أن السياق اختلف فأدّى إلى معان بلاغية دقيقة، فقد جاء صدر الآية في السياق الأول بالفعل المبني للمعلوم بإثبات ( نا ) لله تعالى على التعظيم فقالوا:( وإذ قلنا ) فناسب ذلك المقام ذكر ( رغداً ) على التنكير التفخيمي.. ولما كان الدخول في قوله:( ادخلوا هذه القرية ) غير السكن في قوله:( اسكنوا هذه القرية ) لأن السكن يعني اللبث والإقامة والاطمئنان، فقد جاء في السياق الأول الفاء في (فكلوا ) والثاني ( وكلوا )... وقدّم ( وادخلوا الباب سجداً) على قوله:( وقولوا حطة ) في سورة البقرة وأخّرها في الأعراف لأن السابق في هذه السورة ( ادخلوا ) فبيّن كيفية الدخول.. وفي هذه السورة ( أي سورة البقرة ) ( وسنزيد ) بواو، وفي الأعراف ( سنزيد ) بغير واو، لأن اتصالها في هذه السورة أشد لاتفاق اللفظين. واختلفا في الأعراف فكان اللائق به ( سنزيد ) فحذف الواو ليكون استئنافاً للكلام.
ومن التقديم في المتشابه قوله تعالى:(( ختم على الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم )) ( البقرة 7 )
وقوله تعالى:(( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضلّه الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تتذكرون )) ( الجاثية 23 )
في آية البقرة جاء الحديث قبلها عن المتقين ثم الكافرين الذين ختم الله على قلوبهم التي هي المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، كما جاء في الحديث الشريف، فكان الكلام في هذه الآية على عمومه... أما في آية الجاثية فهي تتكلم عن خاصة بعينها تقع في فئة من الناس، يتّخذون العبادة بأهوائهم، ومن القراءات:( إلهه هواه ) فينتقلون في عبادتهم من حجر إلى حجر أو غيره حسبما يتراءى لهم... فناسب ذلك تقديم الختم على السمع لأنه سمع التعقّل والهداية وهو أداة ووسيلة لنقل الفهم، كما جاء في قوله تعالى:(( ولهم آذان لا يسمعون بها )) ( الأعراف 179 )
ومن ذلك قوله تعالى:(( وجاء رجل من أقصا المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين )) ( القصص 20)
وقوله تعالى:(( وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين )) ( يس 20 )
بداية نرى صدر الآية جاء بـ ( جاء ) دون ( أتى ) لأن ( جاء ) تحيط به معاني العلم واليقين وتحقق الوقوع والقصد.. وبالنظر إلى الآيتين نجد تقديم ( رجل ) في الأولى وتأخير في الثانية لاختلاف المقام فيهما ففي الآية الأولى تقدم ( رجل ) لتسليط الضوء عليه ولفت الذهن إليه وما يحمله من نبأ المؤامرة، بوصوله إلى موسى عليه السلام يتغير الموقف ويخرج موسى متخفياً مترقّباً.. أما في الآية الثانية فالمقام يقتضي تسليط الضوء ولفت الانتباه إلى المدينة بصفة أساسية لا إلى الرجل، فتظهر المدينة على غفلتها وعدم إتباعها المرسلين ثم إرادة الرجل هدايتهم... فتأخر الرجل هنا يبين أنه لم يكن محتاجاً للسرعة والعجلة ومسابقة الزمن بالقدر العظيم الذي كان يحتاجه المقام الأول... ومن هنا يتبين بعد ما ذهب إليه الكرماني في قوله:خصت في هذه السورة ( أي القصص ) بالتقديم لقوله قبله:فوجد فيها رجلين ثم قال ( وجاء رجل) فاكتفى بالنظر إلى التقديم على أساس ذكر الرجلين من قبل لا غير !
ومن ذلك قوله تعالى:(( وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً وغرّتهم الحياة الدنيا وذكّر به أن تُبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله وليٌّ ولا شفيعٌ وإن تعدل كلّ عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أُبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون )) ( الأنعام 70 )
وقوله:(( اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفّار نباته ثم يهيج فتراه مصفرّاً ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلّا متاع الغرور )) ( الحديد 20 )
وقوله تعالى:(( وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون))(العنكبوت64) فآيتا الأنعام والحديد في معرض الحديث عن الدنيا وأحوالها، وفي تدرّج من الأدنى إلى الأعلى فاللعب أولى مراحل الطفولة، والتكاثر في الأموال والأولاد نهاية المطلب وقمة اعتلاء عروش الدنيا... أما آية الحديد فهي في معرض المقابلة بين الدنيا والآخرة، فالأولى لهو ولعب والثانية هي الحياة البالغة، وكان لأسلوب المقابلة هنا حسن التنسيق والإيقاع الجميل، وهي من جملة طرق العرض التي يلجأ إليها القرآن، وهي متكاملة متجانسة مع بقية الأساليب لأداء الأغراض والقيم التي يريدها المنهج القرآني، لكنها تعد من أبرز الطرق الواضحة في العرض، وفي الأداء البياني الذي يسعى إليه القرآن، وقال الكرماني بدأ بذكر اللهو لأنه في زمان الشباب، وهو أكثر من زمان اللعب وهو زمان الصبا.
ومن ذلك قوله تعالى:(( قالوا أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين )) ( المؤمنون 82-83 )
وقوله تعالى:(( وقال الذين كفروا أئذا كنا تراباً وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين )) ( النمل 67-68 )
بتأخير اسم الإشارة ( هذا ) في الأولى، وتقديمه في الثانية ولعل ذلك راجع إلى التفصيل المذكور في آية المؤمنين الموت والتراب والعظام، فأغنى التفصيل عن تقديم اسم الإشارة، وهو لم يقع في آية النمل، وبقي أن نشير إلى أن الآيتين قد صدّرتا بالقول:( قالوا ).... ( وقال ) إشارة إلى أنه زعم باطل ليس له رصيد من اليقين والحق، ثم يصوّر القرآن الكريم مدى اعتمال الانفعال في نفوسهم وإصرارهم على العناد وذلك عن طريق أسلوب القصر بالنفي والاستثناء وبالأداة ( إن ) إيثار على ( ما ) مثلاً.
ومن ذلك قوله تعالى:(( فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضّل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة مّا سمعنا بهذا في آبائنا الأولين )) ( المؤمنين 24 )
وقوله:(( وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذّبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون )) ( المؤمنون 33 )
فقدّم ( الذين كفروا ) على ( من قومه ) في الآية الأولى، وأخّر في الثانية، وذلك لاختلاف المقام وتباين السياق بينهما ففي الأولى صرّح بذكر الرسول فقال:(( ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم... )) ( المؤمنون 23 ) وكرّر ذكر القوم مرتين وأضاف ( قوم ) إلى ضمير نوح لأنه أرسل إليهم فلهم مزيد اختصاص به، ولأنه واحد منهم وهم بين أبناء له وأنسباء، فإضافتهم إلى ضميره تعريف لهم إذ لم يكن لهم اسم خاص من أسماء الأمم الواقعة من بعد[64].
بينما تقدّم ذكر ( قومه ) على ( الذين كفروا ) في الثانية لأنها سبقت بذكر الرسول المرسل منكراً فقال تعالى:(( فأرسلنا فيهم رسولاً منهم )) ( المؤمنون 32 ) وهم قوم هود، فاحتيج إلى تقديم قومه الذين لم يذكروا صراحة ولو مرة واحدة في الآية 32.
وربما كان تقديم ( وقال الملأ الذين كفروا ) لاختصاص القول بهم وشموله لهم وبيان أثر قولهم في قومه وفي الناس كافة، إذ لم يؤمن معه إلا قليل كما جاء صريحاً في القرآن (( وما آمن معه إلا قليل)) ( هود 40 ) وجاء تقديم ( وقال الملأ من قومه... ) لاختصاص القول بقومه – قوم عاد – وبيان أثرهم في الناس. والله تعالى أعلم
الخاتمة:
إن القرآن الكريم معين لا ينضب وجنة فيحاء لا ينقضي ثمرها، بل يظل ملء السمع والبصر، يملك الفؤاد ويستولى على العقل والوجدان... وإننا بعد هذا التطوّف الّذي منّ به الرحمن نذكر من النظرات ما يأتي:
أولاً: إن الإعجاز البلاغي لأسلوب التقديم والتأخير إعجاز فيّاض عظيم التدفّق لا يقع في حصر.. وسبيل التعرّض لفيوضاته وتلمّس أسراره لا يقف عند حد في كلمة أو جملة، بل يشهد السياق في مجمله بستاناً مورقاً يانع الثمار والأزهار، لا تكاد تمد يداً لقطف ثمرة إلا وتجذبك الأخرى والأخرى فلا تستطيع الفراغ حتى تأتي على البستان كلّه.
ثانياً: الألفاظ القرآنية لها دلالتها في سياق الجملة فلا يمكن أن يرادف لفظٌ لفظاً آخر فيتساوى معه في المعنى تمام المساواة، بل إن الكلمة ذاتها لتتكرر في أكثر من سياق لتدلّ على معنى آخر مغاير في كل سياق، فإذا نظرنا إلى دلالة الكلمة المختارة في ظل تقديمها أدّى ذلك إلى إبراز المعنى في قوّة وجلاء، وساعد على تصوير المشهد في تدفّق وحياة.
ثالثاً: كان لأسلوب التقديم سمة أسلوبية بالغة الأثر في معرفة خواص تراكيب الكلام وكشف خبايا النفس والنفوذ إلى أعماقها وتصوير شخصيات المشهد في صورة حضورية تبيّن ما عليها من فرح أو ترح أو اضطراب أو توتر أو إيمان أو نفاق أو نحو ذلك.
رابعاً: كان لأسلوب التقديم والتأخير سمة التغلغل والانتشار في كافّة سياقات القرآن – تقريباً – وكان له دور بارز في آيات الأحكام وأساليب الحوار لا يقلّ بحال عن دوره في الآيات المكّيّة وما حملته من مشاهد القصص أو الآخرة.
خامساً: استطاع أسلوب التقديم أن يخاطب العقل والوجدان في آن معاً، وكان له القدرة على حمل السامع أو القارئ على المشاركة في تفعيل الموقف القرآني وما يبثّه من معان وآداب رفيعة، فنشّط الخيال وحرّك الأذهان والعقول.
سادساً: لا يقف التقديم والتأخير عند حد جزيئات اللغة من كلمات وجمل يقدّم بعضها على بعض وإنما يمتدّ ليشمل الآيات والموضوعات الكبرى التي جاء في ترتيبها توقيفاً من عند الله تعالى بإجماع العلماء، وما كان لآية أن تسبق أختها أو موضوع هو سابق لأخيه إلا لنكتة بلاغية ودلالة معنوية يثبتها السياق في مضمونه وبين طياته.
موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.